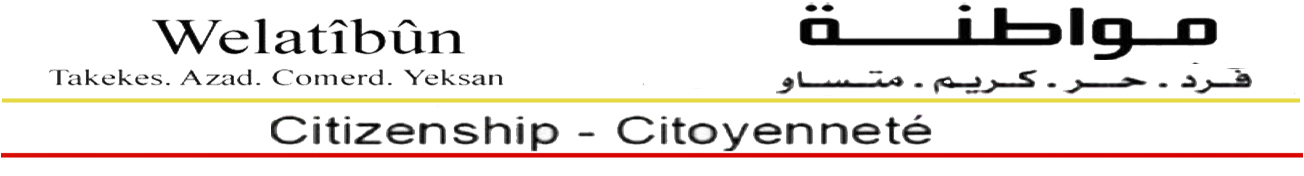رؤية مبدئية في الدستور – محمد معمار
رؤية مبدئية في الدستور
تموز 2011
(1)
بفضل الحركة الشعبية تنتقل سورية من حاجتها التاريخية لـ “عقد اجتماعي” جديد إلى حاجتها السياسية الراهنة لهذا العقد الاجتماعي الذي تتجسد صيغته القانونية بـ”دستور”. فبعد أن بدأ آخر “عقد اجتماعي” شهدته سورية بين عامي 1954 ـ 1957، المجسد بدستور عام 1950، يتآكل منذ عام 1958 أخذ بالتلاشي بعد سبعينيات القرن العشرين حتى لم يتبقَ منه شيءٌ مطلع الألفية الثالثة ـ القرن الحادي والعشرين، بعد عقود بدأت بتغول “السلطة” وشخصنتها مروراً بابتلاع “الدولة” وصولاً إلى تأبيد نفسها وتوريثها.
وإن كنا هنا لسنا بصدد استعراض تاريخ الحياة الدستورية السورية الحديثة والمعاصرة منذ أن كانت سورية ولاية عثمانية تشارك في مجلس “المبعوثان” في ظل أول دستور عثماني في عام 1876 الذي تضمّن تحول السلطنة العثمانية إلى ملكية دستورية برلمانية، ولا مرحلة القانون الأساسي (الدستور) للمملكة السورية الذي أقره (المؤتمر السوري) في جلساته المنعقدة بين 3/6/1919 و 19/7/1920، ولا مراحل التجارب الدستورية زمن الانتداب أو بعد الاستقلال بمختلف عهوده، لكننا سنتوقف قليلاً في بعض المحطات الهامة نظراً لدأب النظام الشمولي في سورية على طمس، والتعتيم على، التاريخ السوري ومسح الذاكرة الجمعية للسوريين بجميع الطرق، في المناهج التعليمية وتقييد الحياة الثقافية والسياسة الإعلامية، وإظهار نفسه وكأنه مبتدأ التاريخ في سورية التي احتضنت الاستيطان البشري الأول منذ أكثر من عشرة آلاف عام، ولن نكرر الحديث عن أول أبجدية وأول “نوتة” موسيقية وأول …
فدستور المملكة السورية الذي أقره المؤتمر السوري، المنوه عنه أعلاه، ينص على أن “نظام الحكم نيابي (برلماني). وأن “السلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية”. ويؤكد على “ضمان الحريات المدنية والدينية والشخصية مما يشبه مبادئ حقوق الإنسان المنبثقة عن الثورة الفرنسية”.
ونص دستور عام 1950 في مقدمته:
“نحن ممثلي الشعب السوري العربي، المجتمعين في جمعية تأسيسية بإرادة الله ورغبة الشعب الحرة، نعلن أننا وضعنا هذا الدستور لتحقيق الأهداف المقدسة التالية: إقامة العدل على أسس متينة حتى يضمن لكل إنسان حقه دون رهبة أو تحيز وذلك بدعم القضاء وتوطيد استقلاله في ظل حكم جمهوري ديمقراطي حر. ضمان الحريات العامة الأساسية لكل مواطن، والعمل على أن يتمتع بها فعلاً في ظل القانون والنظام، لأن الحريات العامة هي أسمى ما تتمثل فيه معاني الشخصية والكرامة والإنسانية. نشر روح الإخاء وتنمية الوعي الاجتماعي بين المواطنين حتى يشعر كل إنسان أنه جزء في بنيان الوطن وأن الوطن في حاجة إليه”.
وبالطبع، وبالتأكيد لا نريد استعادة الماضي لاستنساخه ولكن لنبين إلى أي درك هبطت سورية منذ سبعينيات القرن العشرين حين أصبحت واحدة من مجموعة البلدان التي فصّلت (دساتيراً!؟) على مقياس مصالح سلطات أنظمة شمولية تهيمن بشكل مطبق على الدولة والمجتمع. مما تقدم يتبين كم نحن بحاجة، قبل الدخول في أي حديث عن دستور سوري منشود، إلى تحديدٍ دقيق وواضح للمرجعية العليا والمنظومة “القيمية” الأخلاقية والإنسانية والمعايير القانونية التي تجعل من أي “نص دستوري!” “دستوراً” حقاً في السياق التاريخي الذي تعيشه البشريةـ”الإنسانية” الآن. فعلى غرار تساؤلنا عن “دستورية القوانين” و”قانونية القرارات والعقود” علينا التساؤل عن انسجام “النص الدستوري” مع “القيم” والمعايير الإنسانية العليا في المرحلة الراهنة من تطور البشرية.
فما القيم والمعايير التي تحكم الدستور، أي دستور كي يكون “دستوراً” ؟؟؟!!!
سورية واحدة من خمسين دولة أسست هيئة الأمم المتحدة في مؤتمر سان فرانسيسكو، وهي بصفتها هذه تعد دولة مؤسِسة فيها، وموقِعة على ميثاقها الصادر في 26 حزيران 1945، وملتزمة به، وبجميع الوثائق الصادرة عن هيئة الأمم لاحقاً، ونخص بالذكر هنا “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” المقر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1948. وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بموجب قرار الجمعية العامة في 16/12/1966 الذي يحدد تاريخ بدء النفاذ في آذار 1976. وقد انضمت سورية إلى هذين العهدين بتاريخ 21/4/1969.
إذاً على الدستور السوري المنشود أن يتوافق “نصاً وروحاً” مع ميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق واللوائح والعهود والاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة، وبشكل خاص تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وعلى الدولة السورية القادمة أن تنضم إلى أي من تلك الوثائق التي لم تنضم إليها بعد، وأن تسحب تحفظاتها التي وضعتها الحكومات السابقة على بعض تلك الوثائق عندما وقعت عليها. ومن الضروري أن يتحول هذا التوافق إلى “التزام” صريح وواضح ومعلن يُنص عليه في مقدمة الدستور التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدستور.
وعلى سبيل المثال نذكر هنا بأن “ديباجة” ميثاق الأمم المتحدة تنص على: “نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا (…) نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية”.
كما نصت ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على: “لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم، ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد، ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح، ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد،
فإن الجمعية العامة
تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه جميع الشعوب والأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء”.
وللتذكير ببعض مواد هذا الإعلان نورد:
المادة 1
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 21
- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
المادة 23
- لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية وفى الحماية من البطالة.
- لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
- لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
- لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
المادة 25
- لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
- للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بالحماية الاجتماعية ذاتها سواء أولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
(2)
من كل ما تقدم ينبغي على الدستور السوري المنشود، بـ”نصه” و”روحه”، بجميع “مواده” و”مقدمته” المعتبرة جزءاً لا يتجزأ منه ولها قوة الإلزام القانونية نفسها التي للدستور، أن يجسد ويعكس مفهوم “المواطَنة” بشكل حقيقي وكامل الصدقية. فلن يكون هناك “عقد اجتماعي” صحيح في “الشكل والموضوع” ما لم يكن جميع “أطرافه” “مواطنين أحراراً متساوين”. ولن يكون هناك “وطن” حقيقي ما لم يكن وطناً لشعب جميع أفراده أحراراً. ولن تكون هناك “دولة وطنية” ما لم يكن “الشعب” بأفراده “الأشخاص الطبيعيين الأحرار” مصدراً وحيداً ومطلقاً لـ”السيادة”، وبذلك يكون كل “مواطن” “عنصراً من عناصر السيادة” كما قال روبسبيير قبل أكثر من مئتي سنة.
لقد جاء في المادة السابعة من دستور عام 1950 ما يلي:”المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة الاجتماعية”. وجاء في البند الثالث من المادة (25) من (دستور!) عام 1973: “المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات”. فكم من “مادة” من مواد دستور 1950 قيّدت من تلك المساواة. وكم من عشرات “المواد” من (دستور!) 1973 ألغت هذه المساواة وجعلت منها كلمة فارغة لا معنى لها.
“المساواة” بين “الناس”، بين “المواطنين” إما أن تكون مطلقة وتامة، وغير قابلة للتجزئة و/أو التقييد وإما أن لا تكون. وبهذا المعنى كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واضحاً وتفصيلياً، ففي مادته الثانية نقرأ: ” لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر”.
إن الدستور السوري المنشود مطالب بالمساواة الفعلية بين المواطنين وهذا يقتضي النص على: “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر”.
وحتى لا تصبح هذه المادة “شكلية” و”تجميلية” يجب أن لا يتضمن الدستور مادة، مواداً، تقيد هذه “المساواة” أو تنتقص منها، ناهيك عن أن تلغيها كما في (دستور!) 1973. وعلى سبيل المثال لا الحصر ننوه إلى الحالات التالية:
- على الدستور أن لا يحدد أي دين من الأديان لرئيس الجمهورية، فلكي تتحقق “المساواة المطلقة” بين “المواطنين” في “الحقوق” كما في “الواجبات” يجب أن لا يُحرم أي “مواطن”، بالمطلق، من “حق” الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أكان مسلماً أو مسيحياً، أكان رجلاً أو امرأة، أكان عربياً أو غير عربي.
- تقتضي “المساواة” المطلقة والتامة بين “المواطنين السوريين” في الحقوق والواجبات أن يقتصر تحديد “الجنسية” في الهوية الشخصية لجميع “المواطنين السوريين” بكلمة “سوري” دون أي صفة قومية أخرى. وهذا يقتضي أيضاً تسمية الدولة الجديدة: “الجمهورية السورية”. لكن إذا كان من حق “المواطنين السوريين” من أصول غير عربية أن لا يحملوا بطاقة “هوية شخصية” يكتب عليها (الجنسية: عربي سوري) وإنما (الجنسية: سوري)، وأن يكون اسم دولتهم: “الجمهورية السورية” فإن هذه الدولة ستكون حكماً، وبالضرورة “دولة مركزية” سياسياً (وحدة الأرض والشعب والسيادة)، وفي الوقت نفسه “دولة لا مركزية” إدارياً (قانون إدارة محلية يتيح، من بين ما يتيح انتخاب المحافظ من بين أبناء المحافظة وكذلك مدراء المناطق والنواحي والمخاتير، بالإضافة إلى المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية).
ومبدأ المساواة هذا بين “المواطنين” الأفراد يجب أن ينسحب على “المساواة” بين “الجماعات الدينية والمذهبية والإثنية”. وعليه ينبغي أن تسحب من التداول كلمات ومفاهيم ومصطلحات في جميع القواميس الدستورية والقانونية والسياسية والثقافية والتربوية والإعلامية مثل: الأكثرية والأقلية لوصف الجماعات الدينية والمذهبية والإثنية، فما من جماعة من هذه الجماعات أقلية وكأنها “جالية” غريبة في وطنها. وحصر استخدام مفهوم الأكثرية والأقلية بالجماعات السياسية التي تلتقي على برامج سياسية ـ اقتصادية ـ اجتماعية تتحد في الانتخابات والهيئات التمثيلية. وهذا يقتضي أن ينص الدستور صراحة وبوضوح أن حرية الاعتقاد الديني والمذهبي والعبادات والطقوس، وحق إبراز الشخصية القومية لغوياً وثقافياً وبالعادات والتقاليد …إلخ مصون بالتساوي لجميع “الجماعات الدينية والمذهبية والإثنية”، بغض النظر عن حجمها وعدد الأشخاص المنتمين لها ونسبتهم إلى عدد سكان “الدولة السورية”، ذات “النظام” المركزي سياسياً واللامركزي إدارياً.
ويأتي رفض فكرة “الدولة الفيدرالية” بسبب عدم وجود جماعة قومية في سورية تعيش بشكل متجانس ديموغرافياً على رقعة جغرافية متواصلة بدون تقطع، وليس بسبب رفضها من حيث “المبدأ”. إن تسمية “الجمهورية السورية” لم ينفِ سابقاً أن تكون سورية دولة مؤسِسة في “جامعة الدول العربية، ولا يلغي مستقبلاً أن يكون لها مصلحة في تأسيس “اتحاد عربي” على غرار “الاتحاد الأوروبي”. كما أنه آن الأوان لبناء “الدولة الوطنية” بعد أن أفضت تجربة ما كان يسمى “الدولة القطرية” إلى تهميش “الدولة” وترسيخ “القطرية” تحت ظل الأنظمة التي جاءت لتحقق “الوحدة العربية”. وسيكون أي “اتحاد عربي” يمكنه النجاح في المستقبل هو “اتحاد” بين “دول وطنية” حديثة وديمقراطية وعلمانية على أساس الندية التامة بغض النظر عن حجم الدولة أو تاريخها.
- بعد وضع الدستور الجديد ينبغي وضع قانون جديد للأحوال الشخصية يخضع لمبدأ “دستورية القوانين” تحت طائلة إلغاء أي قانون لا يحقق المساواة بين الرجل والمرأة من قبل المحكمة الدستورية العليا”.
(3)
حددت المادة الثانية من دستور 1950: “السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها”، لكن المادة الثالثة تقيد هذه “السيادة” حين تقرر أن “الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع”. كما حددت المادة الثانية من (دستور!) 1973: “السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور”، لكن مواد ومواد كثيرة في (دستور!) 1973 تلغي “سيادة الشعب” هذه ومنها المادة الثالثة: “الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع”.
إن كانت “السيادة” للشعب حقاً وفعلاً فله وحده، ووحده فقط، أن يكون مصدر التشريع. ولا شك أن الشعب السوري حين يشرّع لابد له بشكل طبيعي أن يسكب في روح تشريعاته من روح قيمه العليا الإنسانية والأخلاقية المستمدة من إيمانه بالرسالتين الإسلامية والمسيحية.
(4)
في النقاش (غير المستفيض هنا) حول طبيعة “نظام الحكم” الأكثر صلاحية في سورية بالارتباط بـ”تاريخية تجربتها الديمقراطية” والمتلخص بالسؤال: هل هو “نظام برلماني” أم “نظام رئاسي”؟، يمكن تكثيف الجواب بأن “روحية” دستور 1950 صالحة لأن تكون أرضية للمناقشة. فمن جهة أولى هو “نظام برلماني”، فالبرلمان ينتخب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مسؤول أمام البرلمان. ومن جهة أخرى فهو ليس نظاماً “برلمانياً” صافياً أو نموذجياً كما هو الحال في إيطاليا (و…)، فرئيس الجمهورية يتقاسم “السلطة” التنفيذية” مع مجلس الوزراء (المادة التاسعة والستون: يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور). وهذا يخلق توازناً، تحتاجه سورية ارتباطاً بـ”تاريخية تجربتها الديمقراطية”، من خلال ما يمكن لرئيس الجمهورية أن يقوم به من خلال صلاحياته بالتخفيف من مخاطر احتمال عدم الاستقرار السياسي (إيطاليا تستطيع أن تتحمل قصر متوسط عمر حكوماتها لكن سوريا لا تستطيع حتى تتكرس الممارسة، وتترسخ التجربة الديمقراطيتين)، فعلى سبيل المثال تقضي (المادة الحادية والثمانون) من دستور 1950 بأنه:
إذا لم يوقع رئيس الجمهورية المراسيم خلال عشرة أيام منذ رفعها إليه أو لم يحلها ضمن المدة نفسها إلى المحكمة العليا لمخالفتها الدستور أو القانون ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبر نافذة. وإذا لم تبت المحكمة العليا في المراسيم المحالة إليها خلال عشرة أيام منذ وصولها إليها ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبر نافذة.
يستثنى من ذلك مرسوم حل مجلس النواب الذي يحق لرئيس الجمهورية رفضه بدون ذكر الأسباب وكذلك مراسيم تصديق أحكام الإعدام.
وكذلك المادة (المادة الخامسة والثمانون):
لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراء.
لا يجوز أن يحل مجلس النواب قبل مضي ثمانية عشر شهراً من انتخابه.
وفي الوقت نفسه لا يستطيع رئيس الجمهورية الاستفراد بالسلطة التنفيذية، فبالإضافة إلى المادة السابقة تقضي المادة (المادة التاسعة والسبعون: كل ما يصدر عن رئيس الجمهورية من مراسيم وصكوك ورسائل تتصل بأمور الدولة يوقعه رئيس الوزراء والوزير المختص ما خلا مرسوم تسمية رئيس الوزراء أو قبول استقالته).
والاستشهاد بتلك المواد لا يعني استنساخ ذلك الدستور وإنما الاستنارة بـ”روحيته”، واعتباره وكأنه مثال توضيحي بمعنى من المعاني. وبالتالي يمكن الاختيار بين “إمكانات” متاحة متعددة تؤدي إلى هدف جوهري واحد، فعلى سبيل المثال: يحدد دستور 1950 مدة رئاسة الجمهورية بخمس سنوات كاملة تبدأ منذ انتخاب الرئيس. ولا يجوز تجديدها إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة على انتهاء رئاسته. وفي هذا المجال هناك خيارات أخرى كأن تحدد مدة رئاسة الجمهورية بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
(5)
في “استقلالية” “السلطة القضائية” تعد “روحية” دستور 1950 “نموذجية” إلى حد كبير. فـ”مجلس القضاء الأعلى” لا يضم أحداً من السلطة التنفيذية في عضويته. فـ (المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: يؤلف مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء: أ ـ رئيس المحكمة العليا رئيساً. ب ـ اثنين من أعضاء المحكمة العليا. ج ـ أربعة من قضاة محكمة التمييز الأعلى مرتبة.).
والمحكمة الدستورية العليا لا يعينها رئيس الجمهورية كما في (دستور! 1973). فـ (المادة السادسة عشر بعد المائة: تؤلف المحكمة العليا من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب من قائمة تحوي أربعة عشر اسماً. ينتقي هذه القائمة رئيس الجمهورية ممن توافرت فيهم المؤهلات الكافية للقيام بعبء هذا المنصب، على أن يكونوا من حملة الشهادات العليا وأتموا الأربعين من عمرهم). وهنا أيضاً توجد “إمكانات” متاحة متعددة، كأن: “يرشح مجلس القضاء الأعلى ضعفي عدد أعضاء المحكمة العليا إلى مجلس النواب لينتخب أعضاء المحكمة من بينهم”. أو “يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أضعاف عدد أعضاء المحكمة ينتقي رئيس الجمهورية ضعفي العدد ويقدمهم لمجلس النواب لينتخب من بينهم أعضاء المحكمة.
وفي مهام المحكمة العليا تنص (المادة الثانية والعشرون بعد المائة: تنظر المحكمة العليا وتبت بصورة مبرمة في الأمور الآتية“: أ ـ دستورية القوانين المحالة إليها ب ـ دستورية مشروعات المراسيم المحالة إليها من رئيس الجمهورية وقانونيتها ج ـ محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء. د ـ طعون الانتخابات. هـ ـ طلب إبطال الأعمال والقرارات الإدارية والمراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية، إذا تقدم بالشكوى من يتضرر منها).
بينما تقتصر مهام المحكمة في (دستور! 1973) على: (تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب، تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين، لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب) فقط، إذ لا يستطيع من يتضرر من القوانين المخالفة للدستور طلب إبطالها من المحكمة الدستورية العليا. كما أنه من المفيد النظر في إمكانية نقل مؤسسة “النيابة العامة” من سلطة وزير العدل إلى سلطة مجلس القضاء الأعلى؟؟؟
(6)
السياسة الدفاعية في دستور 1950 تتحدد بـ (المادة الثلاثون: الدفاع عن الوطن وعن الدستور واجب مقدس على جميع المواطنين. الجندية إجبارية، وينظمها قانون خاص. الجيش حارس الوطن وتنحصر مهمته في الدفاع عن حدود الوطن وسلامته. ينشأ مجلس للدفاع الوطني يحدد اختصاصه وعدد أعضائه بقانون). أما في (دستور! 1973) فتحدد (المادة الحادية عشر): القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى؟! مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية؟!).
ينبغي إحياء “مجلس الدفاع الوطني”، وإلغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة, ويمكن اقتراح أن يتشكل:
- رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيساً
- رئيس مجلس الوزراء عضواً
- وزير الخارجية عضواً
- وزير الدفاع عضواً
- وزير الداخلية عضواً
- وزير المالية عضواً
- وزير الاقتصاد عضواً
- رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة عضواً
- رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية عضواً مراقباً
للمجلس الاستعانة بقادة القوات البرية والجوية والبحرية، ومن يراه مناسباً من الخبراء والمستشارين في جميع المجالات حسب القضايا المطروحة للنقاش.
(7): نقاط متفرقة للنقاش:
- إعلان حالة الطوارئ: موجباتها، مدتها، حدودها الجغرافية، صلاحية كل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ودور كل منها، المستندات القانونية المعمول بها أثناء حالة الطوارئ.
- إلغاء عقوبة الإعدام.
- عدم انتساب القضاة وعناصر الجيش والشرطة للأحزاب السياسية.
- إخضاع الأحزاب والإعلام لمبدأ “علم وخبر”، ناهيك عن التظاهر والاعتصام والإضراب، وللقضاء وحده الفصل في النزاعات الناشئة عن هذه الأمور.
- إعداد قانون الانتخابات على أساس مبدأ الانتخابات النسبية، وجعل سورية دائرة انتخابية واحدة.
- محمد حسن معمار
- الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها وليس بالضرورة عن رأي تيار مواطنة.
![]()