بدائل محتملة للسياسات الاقتصادية النيوليبرالية في سورية- محمد معمار
بدائل محتملة للسياسات الاقتصادية النيوليبرالية في سورية
تقوم على مبدأ العدالة الاجتماعية
يَفترِض رسم البدائل المحتملة للسياسات الاقتصادية الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، الانطلاق من الواقع السوري العياني الملموس في الأمد القريب، والاستفادة من دروس التجربة التاريخية، وامتلاك رؤية لسوريا المستقبل. والأخذ بالاعتبار التشابك الاقتصادي والسياسي والاجتماعي المتبادل تأثراً وتأثيراً.
يقتضي الوصول إلى مستقبل سوريا عبور المرحلة الانتقالية، ولا يمكن القفز فوقها. ستكون المرحلة الانتقالية ذات أهمية بالغة وأثر حاسم في تحديد المستقبل وتوجهاته، لذا نبدأ برؤية المرحلة الانتقالية الكفيلة بإيصال سوريا إلى مستقبلها المنشود.
أولاً: المرحلة الانتقالية
إذا لم تبدأ المرحلة الانتقالية في المدى المنظور، وإذا لم تقم على أسس عملية انتقال سياسي حقيقية وجدية، تقود إلى حل سياسي قابل للتطبيق والحياة والاستدامة فستدخل سوريا إلى جحيم سلسلة من الحروب والعنف والخراب لا يعلم أحد مصيرها. ولا يغير من الأمر شيئاً إذا فُرض حل ظالم بالقوة فالجحيم قادم عاجلاً أم آجلاً. وعندها ستترك كل السياسات لأجيال قادمة في زمن غير محدد.
فما هي سمات المرحلة الانتقالية التي تفضي إلى مستقبل سوري واعد؟ منصة الانطلاق تتجسد بتحقق متلازمة السلام والعدالة الانتقالية. فالعدالة شرط ضروري، وغير كافٍ بالطبع، لقيام سلام راسخ ودائم. فبغياب العدالة سيبقى السلام ضعيفاً، يقيم على حافة هاوية العنف. والسلام المقصود لا يعني وقف الصراع قسراً بالقمع، والتضحية بالحرية. السلام هو نقل الصراع من صراع عنفي إلى صراع سياسي سلمي مدني في ظل سيادة القانون، وعبر القنوات المؤسساتية. سلام يصون الحريات، بما فيها الحريات السياسية، مثل حرية التظاهر والاعتصام ,,,إلخ. إذا تعذر تطبيق العدالة والسلام معاً بشكل متزامن، فالخيار هو السلام أولاً. فالسلام شرط للوصول إلى العدالة بآلياتها: الحقيقة، وتحقيق المصالحة، وإجراء المحاكمات الجنائية، وإصلاح المؤسسات.
تتوقف إمكانية رسم وتطبيق سياسات اقتصادية ذات مضمون اجتماعي، في ظل عملية السلام، أثناء المرحلة الانتقالية على النجاح في بناء “دولة” تمتلك “سلطات” قادرة على الإمساك بالعملية الاقتصادية وتحريك عجلتها. الأمر الذي يتطلب السيطرة على اقتصاد أمراء الحرب، واقتصاد المافيا الموروث من النظام السابق. بذلك يمكن الحديث عن تدشين بناء دولة ديمقراطية تؤمّن سيادة القانون والحريات الأساسية، وتخلق تنمية تحقق المساواة والعدالة الاجتماعية. دولة قادرة على تأمين تمويل مستدام للمؤسسات الديمقراطية والبرامج الاجتماعية والاستثمارات العامة لتعزيز النمو والتنمية، تلك الدولة يمكنها القيام بمهامها الاقتصادية بما ينعكس إيجاباً على الأوضاع الاجتماعية، ومن أهم تلك المهام:
1 ـ جباية الرسوم الجمركية، وكي تصبح حصيلة الرسوم الجمركي مصدراُ مهماً من إيرادات الموازنة العامة لا بد من مكافحة التهريب، ومحاربة الفساد داخل مؤسسة الجمارك. وعدم اتباع سياسة الإعفاءات الجمركية كعامل جاذب للاستثمار.
2 ـ رسم سياسات ضريبية تراعي العدالة، وتعمل على تعظيم الحصيلة الضريبية من خلال:
- التركيز على الضرائب المباشرة وليس على الضرائب غير المباشرة.
- اعتبار الضرائب المباشرة على الأرباح والريوع المصدر الأساسي للحصيلة الضريبية، وليس الضرائب على دخل الرواتب والأجور.
- اعتماد الضريبة التصاعدية على الأرباح والريوع.
- إعفاء حد أدنى مجزٍ من ضريبة الدخل.
- تخفيض الضرائب غير المباشرة على سلع وخدمات الاستهلاك الأساسية. وزيادتها على الاستهلاك الكمالي والتفاخري.
- مكافحة التهرب الضريبي.
- تحسين الجباية الضريبية ومحاربة الفساد.
- عدم اعتماد سياسة الإعفاءات الضريبة كعامل جاذب للاستثمار.
3 ـ اتباع سياسات إنفاقية توسعية تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين بما فيها الصحة والتعليم، وتعمل على خلق فرص عمل، وتسّرع تدوير عجلة الإنتاج.
4 ـ اعتماد التوزيع المنصف بين الشرائح الاجتماعية بما يحابي الفقر، ويقلص الفجوة التنموية بين المناطق.
5 ـ وضع سياسات للأجور والرواتب يؤمن حدها الأدنى حياة كريمة للأسر والأفراد، وربطها بالأسعار والتضخم.
ثانياً: سوريا المستقبل
1 ـ نظرة على التجربة التاريخية السورية:
حاضرنا، اليوم، صُنِع في أمسنا الماضي. وغدنا المستقبلي يُصنع اليوم. ومن لا يستطيع معرفة أخطاء الماضي وعثراته والاستفادة منها، لا يمكنه بناء نجاحات المستقبل وصوابه. تقدم التجربة التاريخية في سوريا، منذ الاستقلال (1946) وحتى نهاية العقد الأول من القرن الحالي (2010)، دروساً غنية وواضحة. تُمكّننا النظرة النقدية للذاكرة التاريخية من بناء حلم المستقبل المرغوب، فهل سنتعظ ونستفيد ونأخذ العبر؟
يمكن تكثيف تجربة سوريا الاقتصادية تاريخياً، في مراحلها الزمنية المختلفة، بعبارة واحدة: “الفشل التنموي”. لكن أسباب الفشل تختلف وتتمايز بين مرحلة وأخرى. سنلخص هذه المراحل بإيجاز وتكثيف.
1 ـ 1: نجاح اقتصادي، وفشل تنموي، في ظل ديمقراطية سياسية (1946 ـ 1958):
شهد الاقتصاد السوري نمواً وتوسعاً صناعياً كبيرين، وبخاصة في الفترة (1953ـ 1957). قُدّر معدل النمو الوسطي في الدخل الوطني بنحو (7%) سنوياً. ويُعد هذا النمو “نمواً حقيقاً” لانعدام ظاهرة التضخم، ولما تتمتع به الليرة السورية من قوة شرائية. وقدَّر الخبير الفني للجمارك السورية، سامي الدجاني، نصيب الفرد من الدخل الوطني بنحو (385) ليرة سورية في العام 1950 أي ما يعادل نحو(102 $) سنويا (الدولار = 3.75 ل.س حينذاك)، وقد يبدو مبلغ 385 ل.س رقماً صغيراً لكن قيمته الشرائية كبيرة جداً، تعادل استهلاك الشرائح الوسطى من الطبقة المتوسطة، أما بحسب تقديرات البنك الدولي فإن وسطي نصيب الفرد من الدخل في الفترة (1949 ـ 1953) يبلغ نحو 425 ل.س أي ما يعادل 113 $.وقد ازداد نصيب الفرد من الدخل الوطني في سورية, حسب النشرة الدورية لمصرف سورية المركزي, من نحو (502) ليرة سورية في العام 1953 إلى نحو (573) ليرة سورية, أي بمعدل نمو وسطي يقارب (3.5%) سنويا. بذلك تعد سوريا في طليعة بلدان الشرق الأوسط. يومذاك تمنى مخاتير محمد أن تصبح ماليزيا مثل سوريا.
| الدولة | سورية | أفغانستان | مصر | الحبشة | إيران | لبنان | السعودية | تركيا |
| نصيب الفرد | 102 $ | 50 $ | 100 $ | 40 $ | 85 $ | 125 $ | 40 $ | 125 $ |
تقديرات الخبير الفني للجمارك السورية سامي الدجاني لعام 1950
لكن ذلك النجاح الاقتصادي لم يسمح بتحول النمو الاقتصادي الكبير إلى “تنمية” حقيقية، متكاملة وشاملة (اقتصادية ـ اجتماعية ـ سياسية ـ ثقافية). لماذا؟ وما الأسباب! لقد اتبعت الحكومات السورية المتعاقبة في تلك المرحلة سياسات اقتصادية متناقضة، نتيجة تضارب مصالح فئات التحالف الطبقي الحاكم.
فقد اقتضت مصلحة كبار المالكين الزراعيين وبقايا الإقطاع عدم حل المسألة الزراعية حلاً برجوازياً. بتحويل علاقات الإنتاج الإقطاعية المنتشرة في القطاع الزراعي إلى علاقات إنتاج رأسمالية وتحديث الزراعة، فظلت المسألة الفلاحية عامل تأزم اجتماعي تساهم بظاهرة عدم الاستقرار السياسي.
وفرضت البرجوازية الصناعية سياسات حماية الصناعة ودعمها وتشجيعها. لكن تلك السياسات طُبقت بشكل معمم دون الاهتمام بأي شرط متعلق بمعايير المواصفات والجودة، الآمر الذي أدى إلى إهمال الصناعيين ضرورة رفع القدرة التنافسية لمنتجاتهم، ومكنهم أيضاً من فرض أسعار احتكارية غير مرتبطة بتكاليف الإنتاج الحقيقية، مما لم يجعلهم بحاجة للاهتمام بزيادة الإنتاجية. كما استمر الصناعيون بإدارة شركاتهم إدارة عائلية بعيداً عن متطلبات الإدارة الحديثة, كل ذلك أدى إلى فشل مشروع التصنيع السوري.
واتفقت مصلحة الجميع مع مصلحة البرجوازية التجارية باتباع سياسة ليبرالية قضت بـ”حرية” السوق الداخلية، بما في ذلك سوق العمل، أدت إلى تدني الأجور، وارتفاع الأسعار قياساً بمستويات الدخل. وكانت النتيجة انخفاض مستويات المعيشة لأغلب السكان. وظل متوسط دخل الفرد المرتفع رقماً حسابياً على الورق، يغطي سوء توزيع.
وجاءت السياسات الضريبية محابية للأغنياء. فقد ازدادت حصيلة الضرائب غير المباشرة بالقيمتين المطلقة والنسبية. وانخفضت حصيلة الضرائب المباشرة بالقيمتين المطلقة والنسبية. بالإضافة إلى انعدام مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي من قبل أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، مما انعكس سلباً على إيرادات الموازنة العامة. وبالتالي انكمشت السياسة الإنفاقية بشقيها الجاري (تعليم، ثقافة، صحة، أجور، تأمين، ضمان …) والاستثماري (بنية تحتية، مجالات استثمارية وإنتاجية ضرورية للمجتمع ولا يقدم عليها الاستثمار الخاص).
كل ذلك أعاق تحويل النمو الاقتصادي الكبير في هذه المرحلة المبكرة من عمر الدولة السورية المستقلة إلى “تنمية” اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة ومستدامة. هذا الفشل التنموي البرجوازي ولّد نقمة شعبية واسعة وطموحاً للتغيير الاقتصادي والاجتماعي نحو العدالة الاجتماعية، وساهم في خلق حالة انعدام الاستقرار السياسي. مما عزز عدم تجذر الوعي الديمقراطي والثقافة الديمقراطية في الوجدان الشعبي وتحولهما إلى نمط حياة. فلم يدافع الجمهور العريض عن الحكم الديمقراطي بوجه الانقلابات العسكرية (ثلاثة عام 1949)، بل وقف متفرجاً إما بشماتة بالحكومة والبرلمان أو مرحّباً بوعود الانقلابين الخلبية بتحسين حياة الناس. كما كانت تلك النقمة أحد دوافع التأييد الشعبي الطوعي الواسع للوحدة مع مصر عام 1958، مضحياً بالديمقراطية براحة ضمير.
وختاماً لا بد من كلمة حق حول تلك المرحلة، تتمثل بأن حيوية المجتمع السوري، آنذاك، الممتلك لمهاراته التاريخية، والمتمتع بحرياته، بالإضافة لطريقة تدخل الدولة في الاقتصاد بالأدوات والأساليب الاقتصادية كانت تشير إلى أن أفق التطور والازدهار كان مفتوحاً على أمل واعد.
1 ـ 2: سياسات اقتصادية ـ اجتماعية، في ظل الاستبداد السياسي (1958 ـ 1970):
في عهد الوحدة بدأت سياسات التأميم والإصلاح الزراعي. ثم قامت سلطة البعث الأولى في عامي (1964 ـ 1965) بتجذير الإصلاح الزراعي، وتوسيع التأميم. أممت معظم الصناعات التحويلية, وكامل الصناعة الاستخراجية, ومعظم التجارة الخارجية, وتدخلت الدولة في التجارة الداخلية. كما تم تأميم المصارف وشركات التأمين، وتأميم التعليم بكافة مراحله. واتبعت سياسة التشغيل الاجتماعي. حدث توسع في التعليم، وتحسنت الخدمات الصحية والمواصلات.
أدت تلك السياسات إلى تقليص الهوة بين الطبقات. وتحسنت مستويات معيشة القاعدة الاجتماعية العريضة، وتراجع الفقر، وتقلصت البطالة الظاهرة، وظهرت “البطالة المقنّعة” بسبب سياسة التشغيل الاجتماعي. لكن ذلك لم يدم لفترة طويلة الأمد، ووصلت السياسات الاقتصادية الهادفة إلى العدالة الاجتماعية إلى أفق مسدود. وكانت النتيجة فشلاً اقتصادياً، فلم يحدث نمو اقتصادي مستدام، وانخفضت الإنتاجية فانعدمت الإمكانية التنموية. وبغياب تلازم “النمو” و”التنمية” تصبح العدالة تعميم الفقر.
يعود ذلك الفشل إلى تطبيق تلك السياسات من قبل سلطة استبدادية صادرت الحريات. لا حرية أحزاب، لا حرية نقابات، لا حرية صحافة، لا حرية تظاهر، لا حرية إضراب، مما يؤدي إلى غياب الشفافية والمساءلة والمحاسبة. وغياب المساواة وتكافؤ الفرص بمعايير الكفاءة والخبرة. وزادت الأوضاع سوءاً هيمنة السلطة على النقابات، وبالأخص النقابات العمالية. كل ذلك سمح باستمرار وتغّول الإدارة البيروقراطية المركزية للاقتصاد. وتواصل عملها بطريقة أوامرية إدارية فوقية، واستمرار ضعف كفاءة إدارات “قطاع الدولة” الاقتصادي وانعدام خبراته.
هكذا انقلبت الآية في سورية ما بين خمسينيات القرن الماضي وستينياته، لكن النتيجة واحدة: عدم تحقق العدالة الاجتماعية. ففي الخمسينيات أدى عدم الاكتراث بالتنمية والعدالة إلى المساهمة في التضحية بالديمقراطية. وفي الستينيات أدى غياب الديمقراطية إلى التضحية بالعدالة والتنمية.
1 ـ 3:هدر الموارد والتنمية ونظام شمولي (1970 ـ 2000):
1 ـ3 ـ 1: عقد السبعينيات:
إثر الحركة التصحيحية، ظهرت ملامح تحولات في النظام الاقتصادي ـ الاجتماعي. فقد نما توجه لمنح دور أوسع للقطاع الخاص، وأطلق شعار التعددية الاقتصادية. فُتح القطاع النفطي أمام الشركات الأجنبية للاستثمار فيه منذ عام 1973. واندفع القطاع الخاص نشيطاً. وظهر استعداد للعودة نحو اقتصاد السوق الرأسمالي.
شهد الاقتصاد نمواً متأرجحاً بسبب مصادره غير الإنتاجية، منها ما هو طارئ كالمنح والمساعدات وأخرى مشكوك في ديمومتها. تكونت تلك المصادر من المنح والمساعدات العربية بعد حرب 1973. ومن زيادة الإنتاج النفطي وارتفاع أسعاره. ومن عوائد عبور النفط العراقي. مما ولّد السمة الريعية للاقتصاد بشكل متضخم.
ظهر تحالف طبقي جديد تألف مما عُرف بـ”البرجوازية البيروقراطية” و”البرجوازية الطفيلية”. هذه الطبقة الوليدة لا تمتلك تقاليد استثمارية. حصلت على ثرواتها بطرق غير مشروعة. قامت بتهريبها إلى الخارج أو تشغيلها في أنشطة اقتصادية غير منتجة ومعظم الأحيان غير قانونية. الأمر الذي أدى إلى ضغوط على موارد القطع الأجنبي، وساهم بخفض قيمة الليرة السورية. وأدى الفساد إلى نمو ظاهرة المليونيرية، إذ ارتفع عددهم في الفترة الواقعة بين (1971-1975) من (55 مليونيراً) في العام 1963 إلى (2500 مليونيراً) في العام 1976. المليونير حينذاك أغنى من الملياردير الآن.
لم يستطع النمو الاقتصادي في السبعينيات أن يتحول إلى تنمية. فلم تُوجّه الاستثمارات نحو مجالات الإنتاج السلعي المادي،وعمت ظاهرة الهدر. بات الفساد ظاهرة عضوية معممة وإفساد ممنهج. وانقلب سلم القيم الأخلاقية في المجتمع. بذلك يكون الاقتصاد قد دخل في مرحلة الانحدار، واختمار أزمته البنيوية نتيجة سماته الريعية.
1 ـ 3 ـ 2: عقد الثمانينيات:
بدأت بوادر الأزمة بالظهور منذ العام 1978. فقد انحسرت مساعدات الدول العربية، وانخفضت عائدات النفط السوري نتيجة انخفاض الأسعار الذي ترافق مع ثبات إنتاجه، وتوقفت عائدات عبور النفط العراقي. واجتمعت تلك الظروف الخارجية مع ظروف داخلية، تمثلت بتنامي البيروقراطية الحكومية، واستشراء الفساد، وفشل الإدارة الحكومية في إنتاج قطاع عام فعال بل خاسر، كبد الموازنة العامة خسائر كبيرة. فقد هبطت معدلات النمو. وانخفضت حصة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات. وازداد عجز موازنة الدولة، فلجأت الحكومة للتمويل بالعجز. واشتدت الضغوط على الليرة السورية وانخفضت قيمتها الشرائية والتبادلية. وتقلصت موجودات المصرف التجاري السوري من العملات الصعبة. وفي ظل هذه الظروف ظهرت الاختلالات الاقتصادية، التي أخفتها المساعدات في السابق. كذلك مجموعة التداعيات الاجتماعية المتمثلة بعدم تناسب معدل النمو الاقتصادي مع معدل النمو السكاني، وبالتالي تراجع حصة الفرد ومستوى معيشته. واشتداد الهجرة من الأرياف إلى المدن والتي ترافقت مع تراجع عدد العاملين في الزراعة. والأهم من ذلك هو في تغير التركيبة الاجتماعية الاقتصادية الذي يتضح في الهامشية المدينية وتضخم العشوائيات. وتضخم حجم القطاع غير المنظم، بما يحمله من سلبيات تطغى على إيجابياته القليلة جداً. وزادت معدلات البطالة، وازداد الفقر المطلق والنسبي.
1 ـ 3 ـ 3: عقد التسعينيات:
بدا عقد التسعينيات، على ما تضمنه من اضطراب وفشل في السياسات الاقتصادية، وبخاصة في مجال جذب الاستثمار، سنوات انفراج نسبي غير مستقر، فاكتشاف النفط الخفيف أوائل التسعينات وتحسن أسعاره عالميا، وفر للدولة ما تحتاجه من قطع أجنبي، وبدأت في تكوين احتياطي من القطع. حررت تلك الإيرادات الموازنة العامة من العجز، ومنحت الحكومة مرونة أكبر في حل مشكلاتها العالقة. كما أتاحت للحكومة منح زيادات على الرواتب والأجور بعد تجميدها لما يزيد عن 6 سنوات. وفُتح باب المساعدات والاقتراض من الدول العربية الخليجية، والأوروبية. وهذا ما جعلها على أعتاب الألفية الجديدة أكثر استعدادا للانفتاح على الخارج، والسير بخطوات متسارعة للاندماج الإقليمي والدولي في ظل سياسات الليبرالية الاقتصادية الجديدة.
وبالنتيجة لم يحقق النظام السياسي الشمولي، خلال عقوده الثلاثة، تحقيق أياً من النمو الاقتصادي المستقر والمستدام أو التنمية أو العدالة.
1 ـ 4: ليبرالية اقتصادية بلا ديمقراطية سياسة، عقد التحضير للانفجار (2000 ـ 2010):
بدأ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعملية انتقال من بقايا نظام اقتصادي مغلق ومخطط مركزياً بإدارة بيروقراطية، يحاول الانفتاح ببطء وتردد خلال العقود الثلاثة السابقة، إلى نظام اقتصاد السوق وسياساته النيوليبرالية. وكان من الطبيعي أن يأتي تطبيق تلك السياسات بشكل انتقائي ومشوه لتلبية مصالح مافياته الاقتصادية. وبالتالي سيحصد الاقتصاد سلبيات السياسات الجديدة بدون أي إيجابية من إيجابياتها. فعلى سبيل المثال لا الحصر، في سلسلة القوانين التي صدرت للتشريع لهذه السياسات صدر قانون “المنافسة ومكافحة الاحتكار”، وأُحدثت “هيئة المنافسة ومكافحة الاحتكار”. لكن القانون لم يُطبق والهيئة لم تعمل. وبقي قطاع الاتصالات الخليوية كما كان احتكارياً. كما استخدم النظام التضليل لامتصاص استياء قاعدته الاجتماعية المتضررة من الانفتاح. فادعى أنه سيطبق سياسة “اقتصاد السوق الاجتماعي”، لكنه لم يقم بأي إجراء لوضعه موضع التنفيذ. فماذا كانت الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية؟
قُدّرت نسبة النمو الاقتصادي في الفترة (2001 ـ 2010) بمعدل وسطي بنحو 4.45% سنوياً. لكن ارتفاع معدل نمو السكان جعل متوسط نمو دخل الفرد لا يتجاوز 2%. وكان النمو متأرجحاً بين سنة وأخرى. ساهم قطاعا تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الحكومية بأكثر من نصف هذا النمو، 30% و 25% لكل منهما على التوالي. والصناعة التحويلية بنحو 7.1% فقط. والزراعة صفر. والصناعات الاستخراجية ناقص 8%. لقد تغير الهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العقد. فقد هيمنت القطاعات الخدمية في الإسهام بالنمو (84.4%)، على حساب إسهامات القطاعات الإنتاجية (15.6%). كان الاقتصاد السوري إنتاجياً فأصبح خدمياً.
ومتوسط دخل الفرد هذا، الذي لم يتجاوز 2%، ليس سوى رقم حسابي على الورق يخفي سوء توزيع الدخل على الأرض. فمن بيانات المكتب المركزي للإحصاء، تبين مسوح دخل ونفقات الأسرة خلال الفترة (2004 ـ 2009) تراجعاً في إنفاقها. بسبب ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية. وأظهرت المسوح أيضاً تناقضاً كبيراً بين المحافظات بالنسبة للمعدل الوسطي لإنفاق الأسرة. يعكس هذا التناقض النمو غير المتوازن بين المحافظات. كذلك التخصيص المشوه للموازنة الحكومية بين المحافظات. توقفت الحكومة عن توسيع التوظيف في القطاع العام بشكل كبير. لم تصل مكاسب النمو، على علاته، إلى غالبية الناس، ولم يكن لصالح الفقراء. فقد تزايد الفقر.
ازدادت الأجور الاسمية زيادة كبيرة لكن الأجور الحقيقية انخفضت خلال هذه الفترة، بسبب الأسعار وتدهور القيمة الشرائية. انخفضت حصة الأجور من الناتج المحلي الصافي، وازدادت حصة الأرباح والريوع أي حصة الفئات الأغنى في المجتمع. ارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير. هاجرت نسب متزايدة من الكفاءات العلمية والمهارات المهنية، تحول معظم الخدمات الصحية إلى خدمات مأجورة، مع تدني سوية تلك الخدمات، وافتقاد الضمان الصحي، تراجعت سورية إلى مراكز متأخرة جداً في مؤشر الفساد الذي أصدرته منظمة “الشفافية الدولية” عام 2008، واحتلت المرتبة 147 على مستوى العالم من ضمن 180 بلداً شملهم المؤشر، متراجعة 9 درجات عن العام الماضي حيث كانت تشغل المركز 138. قدرت الأموال التي سُرقت من سورية نتيجة الفساد وهرّبت إلى الخارج بأكثر من 150 مليار دولار، يعود معظمها إلى “طغمة الفساد التي احتلت مراكز هامة في أعلى هرم السلطة ولمدة عقود من الزمن. كما تقدّر مصادر وزارة المالية السورية حجم التهرب الضريبي بنحو 4 مليار دولار سنوياً يقضمها الفساد وتُحرم منها الخزينة العامة. هذه هي نتيجة السياسات النيوليبرالية الانتقائية بلا ديمقراطية سياسية: لا نمو اقتصادي، لا تنمية، لا عدالة اجتماعية.
1 ـ 5: كيف ردت النُخب، المهتمة بالاقتصاد والسياسة على السياسات النيوليبرالية؟
تعددت مواقف وآراء الخبراء والباحثين الاقتصاديين السوريين، حول السياسات الليبرالية الجديدة وتطبيقاتها في سوريا، وتشكلت مجموعة من التيارات عبرت نفسها من خلال تصورات حول “الرؤية التنموية” الأمثل لسوريا، ويمكن تلخيص أهمها:
الرؤية الأولى: هي التنمية من وجهة نظر الليبرالية الاقتصادية الجديدة. وتعتمد السوق التي تحركها قوى العرض و الطلب, ملبية في ذلك معطيات الربحية.
الرؤية الثانية: هي التنمية عن طريق التطور اللارأسمالي إلى أن تنتقل إلى الاشتراكية في النهاية. وتعتمد في ذلك أساليب القيادة البيروقراطية لاقتصاد شبه مغلق، والتخطيط المركزي.
الرؤية الثالثة: تنادي بالتنمية “المستقلة المعتمدة على الذات” مشددة على دور الدولة في تحقيق التنمية.
الرؤية الرابعة: التي ترى ضرورة اقتران الديمقراطية السياسية بالتنمية الاقتصادية والبشرية والعدالة الاجتماعية، وبعبارة أخرى تلازم الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاقتصادية.
2 : بدائل للسياسات الاقتصادية النيوليبرالية تقوم على مبدأ العدالة الاجتماعية:
لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية إلا على أرض صلبة من تحقق “تنمية حقيقية شاملة ومستدامة”. وهذا يتطلب “نمواُ اقتصادياً حقيقياً” مستنداً إلى قاعدة إنتاج متينة تتمتع بإنتاجية عالية. الأمر الذي يتطلب التخلص من الطابع الريعي للاقتصاد، والقضاء على المافيا الاقتصادية، وإنهاء الفساد الكبير قبل الصغير. وهذا يشترط قيام دولة تتمتع بالشرعية، ذات نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون وتساوي المواطنين أمامه. ونشدد هنا بشكل خاص على استقلال القضاء وعدالته ونزاهته.
أهم السياسات البديلة:
1 ـ دور الدولة:
يجب التخلص من ثنائية: إما الدولة البيروقراطية المتحكمة مركزياً باقتصاد مغلق ومنعزل، تديره بالأوامر الإدارية الفوقية. وإما “الدولة النحيلة” حسب التعبير النيوليبرالي. العدالة الاجتماعية تحتاج دوراً فعالاً للدولة. وهذا الدور يصبح ضرورياً لسوريا القادمة أكثر من أي مكان وزمان. فسوريا ستشهد “إعادة تأسيس” وستقلع من قاعدة انطلاق منخفضة وهشة. وإذا كانت سوريا بحاجة إلى “دولة مركزية سياسياً” لضرورات الأمن والسلام، في المراحل الأولى لانطلاقها على الأقل، فإن التنمية الطامحة للعدالة تحتاج “اللامركزية الإدارية”. لامركزية إدارية حقيقية، ليست شكلية، تقوم على انتخاب المحافظين ومدراء المناطق والنواحي والمخاتير من مناطقهم. وتتمتع المجالس المحلية بسلطات فاعلة وواسعة. وتحصل الموازنات المحلية على حصتها من الموازنة المركزية بما يتناسب مع حاجاتها التنموية بمعايير التنمية المكانية، لتقليص الفجوة التنموية بين المناطق.
دور الدولة في الاقتصاد ليس بديلاً عن “السوق”، وليس بمعزل عنه. أثبتت تجارب التخطيط البيروقراطي المركزي الفاشلة جميعها أن “السوق” هو الأكثر كفاءة في تخصيص الموارد، حتى زمن غير منظور. فما هو دور الدولة في الاقتصاد؟ وهل تدخل في العملية الاقتصادية مباشرة، وكيف؟
بالإضافة لدور الدولة التقليدي كمُنظِم ومُشرِّع وراسم سياسيات، يمكن لها، وواجب عليها، لعب دور حاسم في نهوض سوريا ونموها وتنميتها. على الدولة العمل على زيادة إيرادات الموازنة العامة إلى أقصى حد ممكن، لتتمكن من رسم سياسة إنفاقية توسعية بشقيها: الإنفاق الجاري (صحة، تعليم، بحث علمي، إنفاق اجتماعي يحفز الطلب الكلي ويخلق فرص عمل)، والإنفاق الاستثماري (بنية تحتية حديثة، القيام بمشاريع ضرورية للمجتمع لا يقوم بها الاستثمار الخاص بسبب ضخامة رأسمالها الثابت وبطء دورة رأسمالها وانخفاض ربحيتها).
وبالإضافة لتلك المهام يمكن للدولة القيام بدور اجتماعي كبير من خلال دخول السوق بوصفها “مستثمراً خاصاً” في العملية الاقتصادية، الإنتاجية منها والخدمية, مستفيدة من تجارب فشل القطاع العام. يهدف هذا التدخل إلى التأثير في “حركة السوق القائمة على حرية العرض والطلب”، والإسهام في خلق توازناتها، وتأمين توفر السلع والخدمات الضرورية منعاً للتلاعب والاحتكار، التأثير على الأسعار وتخفيف آثار الغلاء، خلق قنوات لتعبئة المدخرات الصغيرة وضخها في الدورة الاستثمارية، خلق فرص عمل تخفف من البطالة، وتحسين مداخيل عمالها ومساهميها.
ولتحقيق ذلك تقوم الدولة بتأسيس شركات تملكها بالكامل، وشركات مساهمة تملك فيها 51% من أسهمها على الأقل. تُؤسَس هذه الشركات وفق قانون الشركات الذي يُنظّم تأسيس الشركات الخاصة ويحدد طرق إدارتها وعملها ومعاملاتها وتعاملاتها. وتخضع لجميع التشريعات الناظمة للضرائب والتأمين وقوانين العمل والأجور مثل القطاع الخاص, وتعامل أمول الدولة العامة المساهمة في هذه الشركات معاملة الأموال الخاصة أمام مسؤولياتها والتزاماتها القانونية والقضائية.
2 ـ الاستثمار والمناخ الاستثماري:
أهم ما انشغل النظام فيه للترويج لسياساته الليبرالية الجديدة، هو العمل على خلق مناخ استثماري جاذب للاستثمارات وبخاصة الأجنبية منها. تركزت تلك السياسات على أهم عناصرها المتمثلة بتقديم “التسهيلات والإعفاءات الجمركية والضريبية”، وعرض قوة عمل رخيصة. وأهمل عناصر أخرى أكثر أهمية لتعارضها مع جوهر تركيبته البنيوية، مثل سيادة القانون واستقلال القضاء ونزاهته على سبيل المثال. لم تكن سياسية التسهيلات والإعفاءات جديدة، فقد سبقه إليها سلفه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، لكنها كانت إجراءات معدودة ومحدودة الأثر. أما في بداية القرن الجديد أصبحت سياسة معممة وذات آثار خطيرة، وزادت خطورتها مع تراجع إنتاج النفط. لقد حرمت تلك السياسة موازنة الدولة جزءاً مهماً من إيراداتها المفترضة مما انعكس سلباً على السياسات الإنفاقية, وأنتجت تلك السياسة اجتذاب مشاريع صب معظمها في القطاعات الخدمية وليس الإنتاجية. لقد هدفت الرساميل القادمة للربح الكبير والسريع والسهل.
تحتاج سوريا في المستقبل إلى سياسات استثمارية مختلفة، ومن أهمها:
- سيادة القانون
- بنية تشريعية صديقة للاستثمار
- قضاء مستقل عادل ونزيه، وسريع البت في النزاعات
- تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص وتسريعها وخفض تكاليفها
- قيام هيئة الاستثمار الحكومية بدراسات علمية متكاملة لمشاريع محددة، يحتاجها الاقتصاد وتستوفي معايير الجدوى الاقتصادية، وعرضها والترويح لها بهدف اجتذاب مستثمرين جادين
- إنهاء سياسة الإعفاءات المعممة، وإن كان لا بد منها في بعض الحالات فلتقتصر على مشاريع معينة يحتاجها الاقتصاد وتشكل إضافة نوعية
- تشجيع الادخار، وتسهيل ضخ المدخرات الصغيرة والمتوسطة في الدورة الاستثمارية عبر المؤسسات القانونية لقطع الطريق أمام ظاهرة جامعي الأموال
3 ـ السياسات الضريبية:
- جعل تركيب الحصيلة الضريبية تعتمد أساساً على الضريبة المباشرة على الأرباح والريوع، بما يخفف الاعتماد على الضرائب غير المباشرة المفروضة على سلع وخدمات الاحتياجات الأساسية للاستهلاك الشعبي، وزيادتها على الاستهلاك التفاخري والكماليات
- اعتماد الضريبة التصاعدية بما لا يعيق النمو والاستثمار
- إعفاء ضريبي على حد أدنى مجزٍ من الأجور والرواتب
- مكافحة التهرب الضريبي
- مكافحة التهريب الجمركي
- تحسين الجباية الضريبية
- مكافحة الفساد في المؤسسات الجمركية والضريبية
4 ـ السياسات الإنفاقية:
- اتباع سياسات إنفاقية توسعية بشقيها:
- الإنفاق الجاري: على الصحة، والتعليم، والبحث علمي، والتدريب والتأمين والضمان،وإنفاق اجتماعي يحفز طلباً فعالاً يخلق فرص عمل،
- الإنفاق الاستثماري على بنية تحتية حديثة، والقيام بمشاريع ضرورية للمجتمع لا يقوم بها الاستثمار الخاص، بسبب ضخامة رأسمالها الثابت وبطء دورة رأسمالها وانخفاض ربحيتها.
5 ـ سياسات الأجور:
- اعتماد حد أدنى للأجور والرواتب تؤمن حياة كريمة
- اتباع نظام سلالم متحركة للأجور
- سلم يربط الحد الأدنى للأجر بالأسعار والتضخم
- سلم يربط شرائح الأجر العليا بإنتاجية العمل وجودته
- سياسة تأمين وتقاعد تحمي الكرامة البشرية وترتبط بمستويات المعيشة المتغيرة
- سياسة صحية تؤمن الصحة للجميع
- سياسة ضمان اجتماعي شاملة
- سياسة دعم اقتصادي واجتماعي للمحتاجين فقط
6 ـ تنمية القطاع الصغير:
الاقتصاد السوري اقتصاد نمط الإنتاج الصغير. تعمل فيه قاعدة عريضة من السكان، وتعيش منه. لن تحصل تنمية حقيقية وكاملة إلا إذا حدثت تنمية للمشاريع الصغيرة، والصغيرة جداً، والمشاغل الأسرية. وتنمية هذا القطاع لا تقتصر على الناحية الاقتصادية، فنمو هذا القطاع سيقلص البطالة، ويحد من الفقر، ويرفع مستوى معيشة شرائح واسعة من المجتمع. ومن الضروري اتباع سياسات تنموية خاصة به:
- التوسع في إحداث مؤسسات التمويل الصغير
- تسهيل الوصول إلى القروض وتسريع الحصول عليها
- فوائد منخفضة جداً
- الاكتفاء بضمانات التعهد الشخصي دون الحاجة إلى رهونات أو كفالات
- حق الملاحقة القضائية محفوظ لمؤسسة التمويل
- برامج توعية وإرشاد لخلق روح المبادرة الفردية لارتياد الأعمال الصغيرة، وبشكل خاص لدى النساء والشباب
- وضع نماذج ممكنة ومحتملة لمشاريع صغيرة، وصغيرة جداً، وأسرية. يروج لها وتعرض على المستهدفين منها
- المساعدة العملية في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع
- تركيز العمل في الأرياف وعشوائيات المدن
7 ، تنظيم القطاع غير المنظم:
- يشكل القطاع غير المنظم نسبة عالية في الاقتصاد السوري
- يعمل في هذا القطاع أعداد كبيرة من السكان
- لتنظيم هذا القطاع فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية ومعيشية
- يجب ألا يتم التعامل مع هذا القطاع بالحظر والملاحقة بل بالتحفيز والتشجيع والتسهيل
- إجراءات بسيطة للترخيص
- رسوم رمزية
- إيجاد ساحات عامة للتجميع تُخدّم بالماء والكهرباء والتنظيف
8 ، تنمية الاقتصاد التعاوني:
- العمل على توسيع القطاع التعاوني القائم
- تشجيع وتسهيل إحداث الشركات التعاونية، بما فيها الشركات المساهمة التعاونية
- تحفيز النقابات على إحداث مشاريع تعاونية
- قيام البلديات بمشاريع تعاونية مساهمة يساهم بها السكان
9 ـ سياسات التجارة الخارجية:
- تنويع هيكل الصادرات، وزيادة نسبة الصادرات ذات القيم المضافة العالي وخفض نسبة صادرات المواد الخام
- تطوير الصادرات الخدمية مثل السياحة و النقل
- تغيير بنية المستوردات بالتركيز على السلع الرأسمالية والوسيطة وتقليص المستوردات الاستهلاكية عن طريق تطوير إنتاج بدائلها المحلية
- تقوية القاعدة الإنتاجية و الخدمية وزيادة قدرتها التنافسية
- اتباع سياسات حماية ذكية تراعي معايير الجودة والقدرة التنافسية، وبشكل خاص في قطاعات الزراعة والصناعة كثيفة العمالة
- تحويل القيود غير الجمركية إلى قيود جمركية لتسهيل التجارة الخارجية، وزيادة الإيرادات
- تحسين أنظمة التجارة الخارجية بما يخدم زيادة كفاءتها والعمل بشفافية للحد من البيروقراطية وتقليص الفساد
- التركيز على إقامة الشراكات الاقتصادية مع الشركاء المتقاربين في مستويات الإنتاجية والقدرة التنافسية
- العمل على الدخول في تكامل اقتصادي عربي وإقليمي يحسن شروط التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التجارة العالمية
10 ـ تشجيع وتحفيز شركات القطاع الخاص للالتزام بمسؤولياتها الاجتماعية مثل:
- إقامة دورات تدريب مهني للنساء والشباب، تكسبهم مهارات تساعدهم على إيجاد فرص عمل
- القيام، أو الإسهام بأبحاث ودراسات، تهتم بزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة والقدرة التنافسية، والوصول إلى الأسواق الداخلية والخارجية، وتحسين شروط العمل
- تقديم منح دراسية، وبرامج للرعاية الصحية والثقافية والبيئية
- الالتزام بسياسات الأجور والتأمينات والضمان
- الالتزام بدفع الضرائب، وعدم التعامل مع شبكات الفساد
11 ـ تشكيل مجلس اقتصادي ـ اجتماعي:
يتكون المجلس من ممثلين عن الحكومة، والقطاع الخاص، والقطاع التعاوني، والنقابات العمالية والفلاحية والمهنية، والمجتمع المدني بما فيه المنظمات النسائية والشبابية، ومن خبراء وأكاديميين.
ومن مهام المجلس على سبيل المثال:
- تعزيز الحوار الاجتماعي حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، توزيع الدخل، البطالة والفقر، والتعليم، والصحة
- مراجعة وتقييم التشريعات والسياسات
- يساعد السلطتين التنفيذية والتشريعية على اتخاذ قرارات وسياسات تراعي وجهـة نظــر الشركاء المتوافق عليها، وصولاً إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة
- إعداد دراسات وتقارير، ووضع توصيات في الأمور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وما يتصل بها .
- تعزيز مفهوم الشراكة والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني
- تبني وإطلاق المبادرات الريادية في التفكير والتحليل ورسـم السياسات وآليات تنفيذها
12 ـ بمثابة استنتاج أخير: ضرورة اقتران الديمقراطية بالتنمية والعدالة الاجتماعية، أي تلازم الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاقتصادية:
بعيداً عن النظريات، وتجارب البلدان الأخرى المختلفة. تفيد الخصوصية السورية عبر تاريخ يزيد عن نصف قرن الأهمية الحاسمة لاقتران الديمقراطية بالعدالة الاجتماعية، وبتعبير آخر لتلازم وارتباط الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاقتصادية، أو ما يعرف بشكل شائع بالنظام الديمقراطي الاجتماعي.
- في خمسينيات القرن الماضي تحقق نجاح اقتصادي في ظل ديمقراطية سياسية، لكن غياب العدالة الاجتماعية أسهم في انعدام الاستقرار السياسي، وزعزعة الديمقراطية الهشة أصلاً، ولاقى التضحية بها قبولاً شعبياً طوعياً واسعاً.
- في ستينياته نجح الاستبداد السياسي في فرض سياسات اجتماعية، لكنه فشل اقتصادياً، فبقي أثر السياسات الاجتماعية محدوداً ومؤقتاً، ووصل إلى طريق مسدود,
- خلال العقود الثلاثة اللاحقة هدر النظام الشمولي الموارد والطاقات وخلق اقتصاداً ريعياً ضعيفاً عاجزاً عن النمو المستدام ناهيك عن التنمية والعدالة الاجتماعية.
- في العقد الأول من القرن الحالي أوصلت السياسات النيوليبرالية وغياب الديمقراطية سوريا إلى الكارثة.
- تحتاج سوريا في مستقبلها، أكثر من ماضيها، لتلازم الديمقراطية مع التنمية والعدالة الاجتماعية.
*الكاتب: محمد حسن معمار
- الآراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي تيار مواطنة.
![]()

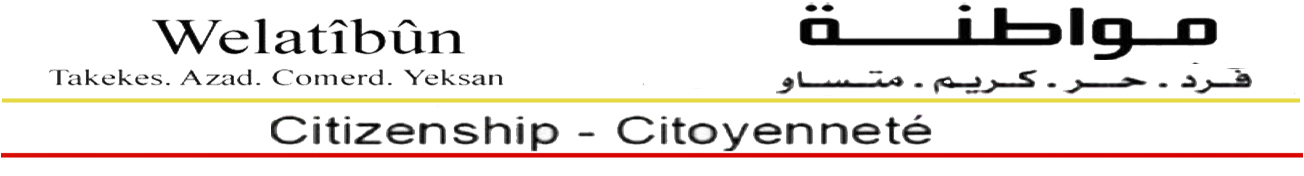
📙 Sending a gift from us. Next >>> https://forms.gle/p6sXcqAS1x7fQ33M8?hs=bcf987a361c6756cdbe9813af7ec0943& 📙
bap9sg
📍 You have a message # 612516. Go - https://graph.org/GET-BITCOIN-02-25?hs=bcf987a361c6756cdbe9813af7ec0943& 📍
rop5is