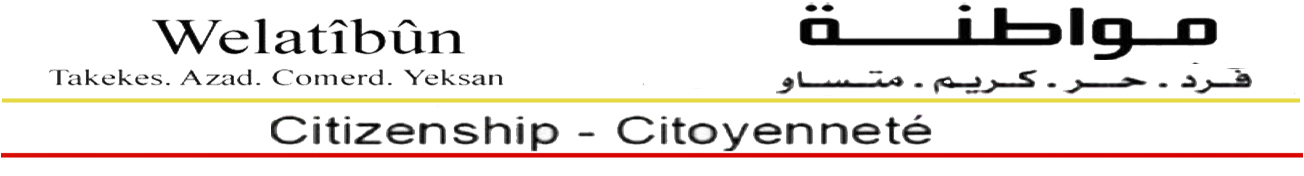التنمية والديمقراطية في سوريا- محمد معمار
(1)
بعيداً عن أي نقاش نظري حول علاقة الديمقراطية بالتنمية، وعن أي تعميم لتجارب بعض البلدان في هذا المجال، ما يهمنا هنا هو كيف أثّرت التنمية على التجربة الديموقراطية السورية في الواقع العياني الملموس. حازت سوريا قصب السبق بكثرة انقلاباتها العسكرية، وعدم استقرارها السياسي في منتصف القرن الماضي. واللافت للنظر غياب الموقف الشعبي المدافع عن الديموقراطية بعد كل انقلاب عسكري. تراوحت المواقف الشعبية بين الشماتة بالحكومات والبرلمان والترحيب بالانقلابات والتهليل للانقلابيين. لا تتطابق أسباب الانقلابات مع أسباب الترحيب الشعبي بها، لكنها تتقاطع في العديد منها.
على أرضية عدم تجذر الديمقراطية، سواء بمعيار رسوخ التجربة دستورياً وقانونياً ومؤسساتياً أو شيوع ثقافتها وتحولها نمط حياة بين الناس، تنتصب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في صدارة العوامل المُفسرِة للمواقف الشعبية. بينما يتراجع هذا العامل بين دوافع وأهداف الانقلابيين، وإن كانوا يستفيدون من السخط الشعبي الناجم عن الإحساس بالظلم والحرمان. لا نقصد من موضوعنا هذا محاكمة الماضي، على أهمية ذلك، إنما نريد بناء معرفة وامتلاك “رؤية” للمستقبل.
(2)
يمكن صياغة “المشكلة” الاقتصادية الاجتماعية آنذاك وتشخيصها بعبارة وجيزة تتلخص بـ: عجز الحكومات عن تحويل “النمو الاقتصادي” الكبير والطويل المدى، في خمسينيات القرن الماضي، إلى “تنمية” حقيقية. ولنبدأ بتحديد “المفاهيم” قبل مناقشتها. “النمو الاقتصادي” هو التغير الكمي، ومعدلاته محسوبة بنسب مئوية، لقياس الزيادة أو النقصان في المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية خلال فترة زمنية. أما “التنمية الاقتصادية” فهي التغيرات الكمية والنوعية وانعكاسها على مجمل مستويات الكيان الاجتماعي المتعددة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. إلى أين تذهب نتاجات النمو؟ وكيف توزع؟ وهل كانت السلع والخدمات المُنتَجة تذهب لإشباع رغبات فئة اجتماعية ضيقة، أم لتلبية الحاجات الأساسية لأوسع قاعدة اجتماعية في المجتمع. وهل كان الدخل الناتج عن النمو يوزع بشكل يراعي نوعاً ما من العدالة النسبية ويُضيّق الهوة بين فئات السكان المختلفة، والمناطق المتعددة لأقاليم البلد الواحد؟. وهل كان يخصص جزءاً من ذلك الناتج لمعالجة مشكلات اجتماعية حادة مرشحة لتصبح متفجرة مثل: البطالة والفقر المطلق، والنسبي. إضافة لرفع قدرة المجتمع، كل المجتمع، وتفتح طاقاته مادياً وروحياً.
في خمسينيات القرن الماضي نما الاقتصاد نمواً كبيراً وسريعاً بمعدل وسطي (7.4%) سنويا. ويعد ذلك النمو حقيقياً في ظل غياب ظاهرة “التضخم” الاقتصادي حينذاك. كما نمت “حصة الفرد” من الدخل بمعدل وسطي (3.4%) سنوياً. كانت سورية في طليعة بلدان الشرق الأوسط في مؤشر متوسط دخل الفرد، لكن لابد من التنويه بأن هذا المؤشر حسابي يُخفي الفروقات في الدخل الفعلي بين الطبقات والشرائح الاجتماعية. لكن السياسات الحكومية الاقتصادية جاءت انتقائية ومتناقضة نتيجة تعارض المصالح داخل التحالف الطبقي الحاكم، سواء منها المصالح الراهنة أو بعيدة المدى. وتناقض مصالح مجمل التحالف مع مصالح بقية الطبقات والشرائح الاجتماعية. والتناقض بين الاقتصاد السوري ذي الطبيعة الإنتاجية السلعية والاقتصاد اللبناني ذي الطبيعة الخدماتية. نتج عن هذه السياسات إنهاء الوحدة الجمركية مع لبنان، وتحقيق الاستقلال النقدي لليرة السورية، وتأميم أهم الشركات الأجنبية الكبرى، وانتهاج سياسة حماية ودعم وتشجيع الصناعة. وبالنتيجة فإن انتقائية السياسات وتناقضها لم تُمكَن من الاستفادة من نقاط القوة في الاقتصاد السوري ومعالجة نقاط ضعفه.
(3)
فقد قضت مصالح البرجوازية الصناعية انتهاج سياسات غير “ليبرالية” فيما يتعلق بالصناعة. والتأسيس المبكر لسياسة تدخل الدولة في الاقتصاد ولعب دور مُؤثر فيه. فاتبعت سياسة حمائية داعمة للصناعة حمت الإنتاج الصناعي المحلي وساعدت على نموه، ولكنها أضرت بجودة المنتجات وقدرتها التنافسية بشكل خاص والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بشكل عام. تم إعفاء المشاريع الصناعية من الضرائب والرسوم في السنوات الأولى من ممارسة النشاط (3-6) سنوات وإعفاء الآلات والتجهيزات الصناعية من الرسوم الجمركية، ومنع استيراد المنتجات الصناعية الأجنبية التي تنتج الصناعة السورية مثيلاً لها. وأُحدثت شركات مساهمة كبيرة في الصناعة وتوسعت بسرعة، لكنها ظلت تدار عائلياً. أدى اجتماع الإدارة العائلية للقطاع الصناعي بديلاً عن الإدارة الحديثة بطريقة علمية، مع عدم اختيار أدوات وأساليب للحماية والدعم لا تؤدي إلى إهمال “المواصفات” و“الجودة”، إلى إعاقة نجاح “مشروع التصنيع السوري” الذي بدا واعداً مع التوسع والنمو الكبيرين في الصناعة والاستثمار الصناعي.
(4)
بينما قضت مصالح الإقطاعيين وكبار الملاكين الزراعيين باتباع سياسات غير “رأسمالية” في القطاع الزراعي، قطعت الطريق أمام حل المسألة الزراعية حلاً برجوازياً، يُدخل علاقات الإنتاج الرأسمالية في القطاع الزراعي ويحدّثه بطريقة عصرية. وقبلت البرجوازية بذلك لأنها لم تكن قد قطعت حبل السرة مع الإقطاع. إذاً وقفت البرجوازية إلى جانب الإقطاع بحزم في الدفاع عن علاقات الإنتاج الإقطاعية وشبه الإقطاعية. وعدم القيام بإصلاح زراعي يقلص التفاوت الكبير بين الملكيات الزراعية ويوسع القاعدة الاجتماعية للتملك. الأمر الذي لم ينزع فتيل الانفجارات الاجتماعية في صفوف الفلاحين.
كانت للزراعة أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرتين. فحتى الخمسينيات ساهمت الزراعة في تكوين الدخل الوطني بنسب تراوحت مابين (40-43%) في معظم السنوات، 1953 و1956 و1957، ويشتغل فيها ويعيش منها أكثر من نصف السكان. وكانت السمة العامة لعلاقات الإنتاج السائدة في الزراعة هي علاقات الإنتاج الإقطاعية، على الرغم من وجود عدة أشكال انتقالية للملكية الزراعية تعكس مختلف مراحل تلاشي الإقطاعية وقيام الرأسمالية. وإن كان من الصعب معرفة حجم أشكال الإنتاج الرأسمالية المتنامية في الملكيات الزراعية، فإنها بقيت جزراً صغيرة في محيط العلاقات الإقطاعية الكبير. ومهما تكن أشكال الاستثمار الزراعي، فقد بقي الفلاح السوري يخضع لاستغلال لا يرحم. ومنذ عام 1955 طُرح في البرلمان السوري مشروع قانون يمنع طرد الفلاحين من الأراضي المؤجرة دون جدوى. وفي جلسة للمجلس النيابي، بتاريخ 4 آذار عام 1957، انسحب معظم النواب منها ولم يبقَ سوى 38 نائباً، أُقر قانون منع تهجير الفلاحين من قراهم بمادة وحيدة، وحصل على أكثرية نسبية، 36 صوتاً فقط من أصل 144 نائباً. وجاء هذا “الإنجاز” المتواضع متأخراً جداً، فبعد أقل من سنة ستتحد سوريا مع مصر التي كانت قد شهدت “إصلاحاً زراعياً” بعد أشهر قليلة من انقلاب 23 تموز 1952. فهل من عجب في تأييد الشعب السوري الواسع طوعياً للوحدة مع مصر (22 شباط 1958) التي كان مهرها رأس الديمقراطية في سوريا.
لم تخذل حكومة الوحدة الفلاحين، ففي 4 أيلول 1958 صدر القانون رقم 134 المعروف باسم “قانون تنظيم العلاقات الزراعية” ويهدف لإقامة علاقات عادلة اجتماعياً (أو بالأحرى أقل لا عدالة اجتماعية) بين مالكي الأرض والمزارعين والعمال الزراعيين. وصدر في 27 أيلول 1958 قانون الإصلاح الزراعي رقم (161) المتعلق بتحديد الملكية الزراعية وتوزيع الأراضي الزائدة المصادرة من كبار الملاك على المعدمين من الفلاحين وصغار المزارعين.
ولم تستفد البرجوازية السورية من التجربة، إذ عادت إلى سياستها “ضيقة الأفق” خلال فترة حكمها القصيرة والأخيرة بين انقلابين (28 أيلول 1961 ـ 8 آذار 1963). فقامت بعدة خطوات جزئية وتدريجية منها تجميد قانون الإصلاح الزراعي عن طريق تطعيمه ببعض الأحكام والنصوص التي تحول دون تنفيذ مضمونه، وإلغاء تأميم عدد من الشركات الصناعية. وسرعان ما عادت التناقضات التي كانت قائمة في مرحلة ما قبل الوحدة، والسابقة على الإصلاح الزراعي والتأميم. مؤدية إلى سخط شعبي واسع تحول إلى حركة سياسية نشطة لم تسمح للحكم الجديد بالاستقرار. فهل كان من المنتظر أن يقف الفلاحون والعمال بوجه انقلاب 8 آذار 1963، الذي سيعمق الإصلاح الزراعي ويوسع التأميم ويتبع سياسة التشغيل الاجتماعي. وهكذا كانت المسألة الزراعية وقضية الفلاحين من العوامل المهمة لغياب الاستقرار السياسي، وعدم الدفاع عن الديمقراطية.
(5)
بالمقابل قضت مصالح جميع أجنحة التحالف الطبقي الحاكم على تطبيق سياسات “رأسمالية” و”ليبرالية” تجاه “السوق الداخلية” بما في ذلك “سوق العمل”. التي ستؤدي إلى تدني الأجور بسبب ترافق ظاهرة النمو الصناعي مع هجرة الفلاحين من الريف إلى المدينة، مما أدى إلى زيادة عرض قوة العمل، أي رخص الأيدي العاملة، و بالاستفادة من ضعف الحركة النقابية غير القادرة على فرض مستويات أعلى للأجور. كما عملت حرية السوق الداخلية على رفع أسعار السلع الاستهلاكية. وبالنتيجة انخفض مستوى المعيشة لأغلب السكان عموماً.
كما اتبعت سياسة ضريبة محابية للضرائب المباشرة، وتساهلت مع ظاهرة التهرب الضريبي. مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضرائب غير المباشرة بالقيمتين المطلقة والنسبية، وللتذكير فإن هذا النوع من الضرائب تتحمله أساساً الطبقات الشعبية. وانخفاض الضرائب المباشرة بالقيمتين المطلقة والنسبية التي تدفعها الطبقات الغنية. ولما كانت الضرائب تشكل معظم إيرادات ميزانية الدولة حينذاك قبل اكتشاف النفط والغاز. وبالمحصلة تدنت حصيلة إيرادات ميزانية الدولة مما أدى إلى ضعف السياسة الإنفاقية بشقيها الجاري (الصحة والتعليم والثقافة والتدريب والبحث العلمي) والاستثماري (البنى التحتية وتطوير القوى المنتجة والاستثمار في قطاعات ضرورية يعزف القطاع الخاص عن الاستثمار بها).
إن ضعف الإنفاق الحكومي الجاري والاستثماري، وتدني الأجور سيؤديان إلى خفض القدرة الشرائية في السوق الداخلية، وإلى عدم زيادة التشغيل (التوظيف). وهذا سيفاقم التناقضات بين الإنتاج والاستهلاك، بين العمل ورأس المال، الذي سينعكس على طبيعة وأشكال حراك البنية الاجتماعية.
فهل يستفيد السوريون من التجربة التاريخية السورية، والنظر إلى المستقبل برؤية تنموية حقيقية شاملة ومستدامة، داعمة للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي؟! ويدافعون عن الديمقراطية. وهل يقتنع الليبراليون بأن التخلي عن “الليبرالية السياسية” والتمسك بليبرالية اقتصادية منفلتة من أي قيد اجتماعي وشرط إنساني وأخلاقي، لن يؤمن لهم مصلحتهم على المدى البعيد، فديمومة مصالحهم واستمرارها بحركة انسيابية مرهون بالسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي. كما على الاشتراكيين أن يستفيدوا من التجارب “الاشتراكية”! ويسلموا باستحالة قيام “ديمقراطية اقتصادية” دون “الديمقراطية السياسية” وخارجها. على الجميع في سوريا الجديدة أن يؤمنوا بأن: للديمقراطية جناحان لا تحلق إلا بهما معاً، الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاقتصادية.
* الكاتب: محمد حسن معمار
- المقالات التي تعبر عند آراء كتابها لا تعبر بالضرورة عن رأي تيار مواطنة.
![]()