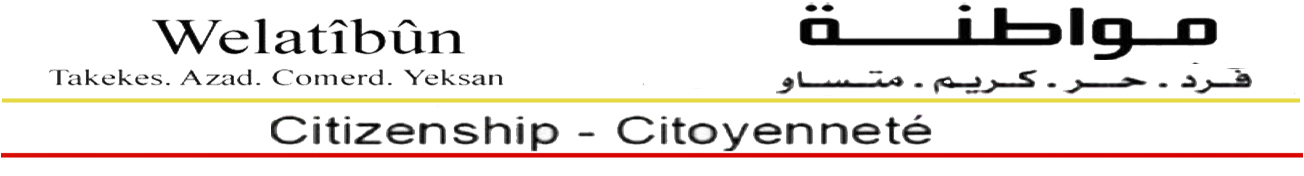وجهة نظر تيار مواطنة حول المسألة الكردية- 27/11/2012
سوريا المستقبل والمسألة الكردية:
الثورة السورية “ثورة سياسية” وذات “طابع تاريخي”، إن لم نقل “ثورة تاريخية” مخافة المبالغة في التوقعات والإغراق في التفاؤل. وهي تواجه تحديات كبيرة بقدر ما تحمل من آمال عريضة. فالمأمول منها لا يقف عند حد تغيير “النظام السياسي”، وإنما إعادة بناء “دولة” سورية وولادة “شعب” سوري بـ”هوية وطنية” سورية. فمشكلة سورية لم تكن تقتصر على بدء تآكل “عقدها الاجتماعي” منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي وصولاً إلى تلاشيه خلال الأربعين سنة الماضية وحسب، وإنما في عيوب وقصور اعترت “عقدها الاجتماعي التأسيسي” الأول. فعلى الرغم من أن الفصل الأول من دستور 1950 جاء تحت عنوان “في الجمهورية السورية” نصت المادة الأولى منه على أن: “سورية جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة. وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيها. والشعب السوري جزء من الأمة العربية”. وفي حين قضت المادة السابعة بأن: “المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة الاجتماعية.” لم تكمل لتقول: “بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس …”، تماشياً مع المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان: “لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.” وإذا كان هذا هو الحال على المستوى النظري، دستورياً وما ينتج عنه من تشريعات ومؤسسات، فإن حال مستوى الواقع العملي الممارس للسوريين هو الأخطر. فلقد عاشت الغالبية الكاسحة من السوريين ازدواجية عميقة ومزمنة، بين ما يحملونه ويرفعونه من آيديولوجيا وشعارات وأهداف “قومية عروبية” عابرة بترفع عن “الوطنية السورية”، وبين ما يعيشونه حقيقة في حياتهم اليومية من انتماءات وعلاقات ومؤسسات طائفية ومذهبية “ما تحت وطنية” دون أن يرتقوا إلى “هوية وطنية” سورية. وأدى هذا التناقض، فيما أدى إليه، إلى ضعف “بناء دولة وطنية سورية” مقابل تورم “قطر سوري” يسعى إلى دولة عربية منشودة، وهشاشة “وجود شعب سوري” مقابل “شعب عربي في سورية” يقصي ويهمش السوريون من غير العرب، والكرد منهم على وجه الخصوص.
مما تقدم تتضح إحدى أكبر التحديات أمام سوريا المستقبل، ألا وهي بناء “دولة وطنية” سورية قائمة على “عقد اجتماعي” جديد يفتح صيرورة لاندماج اجتماعي يفتح صيرورة لخلق “شعب سوري” يحمل هوية “وطنية سورية”. يبدأ هذا العقد الاجتماعي بالحقوق المتساوية للمواطنين بغض النظر عن العرق والدين والجنس، ولا ينتهي عندها. فالحقوق يجب أن تشمل الحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين من مختلف الأعراق والقوميات بلا تردد أو استثناء. يضاف إلى ذلك الحقوق الخاصة بالكرد. وإذ نميز الكرد عن غيرهم من الأصول القومية الأخرى، غير العربية، فذلك بسبب الوضع الديموغرافي والتاريخي الخاص بهم والمختلف عن بقية الأقوام الأخرى. فليس لكل من السريان والآشوريين والأرمن والشركس والتركمان مطالب وطموحات تتعدى حقوق المواطنة المتساوية والحقوق الثقافية واللغوية والسياسية المتناسبة مع وجودهم التاريخي والراهن على الأرض السورية وطموحاتهم الذاتية، لأسباب تاريخية وجغرافية وسكانية غنية عن التعريف. من هنا تتوقف صحة “العقد الاجتماعي” السورية على معالجة “خصوصية” المسألة الكردية في سورية. والمدخل الصحيح لحل المسألة الكردية في سورية ينطلق من أمرين اثنين، يتجلى أولهما بأن يعيد السوريون من أصل عربي النظر بالمسألة الكردية من اعتبارها “مشكلة أكراد في سورية” إلى اعتبارها مسألة “وطنية سورية” بامتياز، ويتوقف على معالجتها بشكل صحيح رسم مستقبل سورية المأمول. والأمر الآخر يتعلق بمدى إمكانية أن ينظر الكرد السوريون بوصفهم جزءاً من الشعب الكردي إلى قضيتهم، في المدى المنظور والمستقبل الراهن على الأقل، بأنها “قضية سورية” يحملها سوريون من أصل كردي للوصول إلى أفضل تصور لمستقبل سورية.
ولأن معالجة “القضية الكردية” معالجة تاريخية تتعلق بالأمة الكردية وثقلها الرئيس خارج سورية من جهة أولى، ومعالجتها من منظور مبدأ “حق الشعوب في تقرير مصيرها” من جهة أخرى، تمت في فقرات سابقة فسنحصر نقاشنا في هذه الفقرة على معالجتها من خلال الاحتمالات المتاحة والممكنة في الواقع العياني الملموس في الظروف السورية الراهنة بملابساتها وتعقيداتها.
من الطبيعي، والمبرر، والمفهوم أن تعلو الأصوات الكردية، وتصبح واضحة وعلنية وجذرية بعد الثورة في سورية، بعد أن كانت الآراء والطروحات نفسها تُقال في السابق بخفوت وفي الغرف المغلقة وعبر بعض الأدبيات الحزبية الجذرية. ومن الطبيعي أيضاً أن يتم الحديث عن “ربيع كردي بعد الربيع العربي”، وأن يتم التذكير بأن “ربيعاً كردياً” سبق الربيع العربي في القامشلي عام 2004. وكما يقال، بحق، بأنه لا يمكن تجاوز “عطش الكرد إلى حكم أنفسهم ذاتياً”، وبأن “الحل الوحيد يتمثل بالفدرالية”. فهل الفيدرالية ممكنة عملياً في الواقع السوري المشخص عيانياً؟
ينتشر الشعب الكردي في سورية على مساحات شاسعة من الأرض، وتتموضع التجمعات السكانية ذات الأغلبية الكردية بشكل متباعد جغرافياً، وتتداخل هذه التجمعات متشابكة مع تجمعات سكانية عربية وسريانية وآشورية وأرمينية وتركمانية وشركسية. فكيف ستقام منطقة حكم ذاتي كردية ترتبط بسورية بنظام حكم فيدرالي، في ظل غياب استمرارية سكانية، غير متقطعة وغير متداخلة، على أراضٍ غير متواصلة جغرافياً؟ فهل يمكن ذلك عن طريق تبادل أراضٍ ونقل سكان؟ أم أن هناك حلاً لا يمكن وصفه بالفيدرالي ولكنه يحقق معظم أهداف وغايات الفيدرالية؟ وما هو هذا الحل.
قبل الثورة، وبعيداً عن المسألة الكردية، كانت تُطرح “رؤىً” لسورية ما بعد النظام الشمولي، يحملها سوريون من منظور “تنموي” حقيقي وفعال. فمن أجل “تنمية حقيقية شاملة ومستدامة”، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً، لا بد من نظام سياسي مختلف. فبالإضافة إلى ضرورة ربط التنمية بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتوزيع العادل للثروة، يجب إقامة “دولة” “مركزية سياسياً” و”لا مركزية إدارياً”. وكي لا تبقى المسائل في العموميات وبشكل ضبابي، كان يُقال بوضوح أن “اللامركزية الإدارية” تتطلب نصوصاً دستورية وتشريعات قانونية تقتضي، فيما تقتضيه، أن يتم انتخاب المحافظين ضمن محافظتهم من قبل أبناء المحافظة. وكذلك مدراء المناطق والنواحي والمخاتير. وأن تتمتع السلطات المحلية بصلاحيات حقيقية وواسعة، وأن تكون مسؤولة أمام ناخبيها عبر صناديق الاقتراع في كل دورة انتخابية، وحتى أمام القضاء عندما يتطلب الأمر ذلك. وأن تكون حصص الميزانيات المحلية من الميزانية المركزية متناسبة مع الحاجات والأعباء التنموية، وذلك لصالح المناطق الأقل نمواً. ويمكن التفكير بأفكار أخرى ضمن نقاش وطني عام في المرحلة الانتقالية. ومن هذه الأفكار على سبيل المثال لا الحصر إمكانية إعادة التقسيمات الإدارية في سورية، كأن تقسم سورية إلى أقاليم، يضم كل إقليم مجموعة من المحافظات، وتكون إدارة الإقليم منتخبة من قبل أبناء الإقليم. كما يمكن التفكير بتعديلات على حدود المحافظات إذا اقتضى ذلك ضرورات العملية التنموية، اقتصادياً وبشرياً وثقافياً. ويجب أن يبقى النقاش حول هذه الأفكار وغيرها عاماً ومفتوحاً.
وفي النهاية، ولأسباب كثيرة لا مجال هنا لمناقشتها وتحليلها، يجب التأكيد، بوضوح وصدق وحزم، على أن “المركزية السياسية” هي “ضرورة وجودية” لأي “دولة” سورية، والتفريط بها هو تفريط بوجود “دولة سورية” أصلاً. لكن المركزية الإدارية ليست كذلك.
تيار مواطنة
دمشق- 27/11/2012
![]()