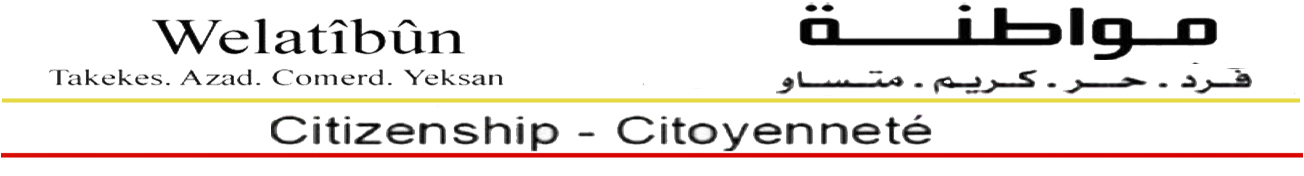العلمانية في السودان الجديد

يصعب الحديث عما آل إليه السودان بعد ثورة نيسان2019 دون المرور، ولو سريعاً على محطات تاريخها الحديث، منذ الاستقلال، الذي شهد ثلاثة فترات من الحكم المدني هي الأقصر، والبقية كانت للحكم العسكري، أما القوى السياسية المسيطرة فقد كان أهمها حزب الأمة المستند على الطريقة الصوفية “الأنصار” والحزب الاتحادي مدعوماً من طائفة” الختمية” الصوفية أيضاً، وهذان الحزبان كانا مع الحكم المدني دائماً، أما القوة الثالثة في الأهمية فقد كانت “الإخوان المسلمون” الذين كان لهم الدور الأكبر في حكم السودان منذ انقلاب 30يونيو 1989، حتى سقوط نظام البشير في 11 / إبريل 2019. مع دور محدود للحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث وبعض الليبراليين.
واجهت الأنظمة أو الحكومات المتعاقبة، بعد الاستقلال، ثلاثة تحديات رئيسية هي مسألة الدستور بسبب إلغاء الحكم الذاتي المعمول به سابقاً، لتسهيل الحصول على الاعتراف العالمي بالاستقلال، وكذلك مشكلة الجنوب ذات البعدين الديني و الإثني، حيث تم تأجيل الفدرالية المقترحة للأقاليم الجنوبية الثلاثة، كما كان قد حدد البرلمان السوداني في مطالبه قبل الاستقلال، وأخيراً معضلة التنمية في السودان، إلى جانب تحدي الصراعات الأيديولوجية بين الأحزاب اليمينية واليسارية وبين الديمقراطيين والشموليين.
بداية، وفيما اعتبر خروجاً من مأزق يعيشه السودان، شكل الانقلاب العسكري على السلطة في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1958م بقيادة الفريق إبراهيم عبود أول ضربة لنظام التعددية الحزبية في السودان، ومقدمة لسلسلة طويلة من الانقلابات العسكرية، وقد بقيت مشكلة الدستور معلقة، حيث كان الدستور المؤقت المعمول به، صورة معدلة لقانون الحكم الذاتي أيام الاستعمار. وتم تأجيل صياغة دستور دائم للبلاد لتجنب نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يترأسه الفريق عبود إلى برلمان منتخب. وبالإضافة إلى المشكلة الدستورية شكلت مشكلة الجنوب بصفتها مشكلة إثنية ودينية، تحدياً حقيقياً لعبود ولجميع لجميع السلطات المتعاقبة، وقد قامت حكومة عبود بتعيين بعض السياسيين الجنوبيين في مناصب قيادية، لكن جميع هذه الإجراءات لم تتمكن من معالجة المشكلة.
وبسبب عدم حل مشكلة الجنوب عل أساس فدرالي، طرحت حركات عسكرية فكرة الاستقلال وبدأت حرب عصابات في الجنوب أدت إلى تدهور الوضع الأمني، وحدوث حراك سياسي أدى إلى استقالة المجلس العسكري ثم تخلي عبود عن الحكم لصالح مجلس رئاسي، وهكذا بدأت الفترة الديموقراطية الثانية في تشرين الأول عام 1964وعاد الحكم المدني والحياة الحزبية. وشاركت في البرلمان أحزاب وحركات جنوبية ومن شرق السودان. وأعلن عن عفو عام عن المتمردين في الجنوب وتم عقد مؤتمر لمعالجة مشكلة الجنوب طرح فيه الجنوبيون تصورات تتراوح بين الفيدرالية و الكونفيدرالية وحق تقرير المصير، تلك التصورات التي لم تكن مقبولة من قبل الشماليين الذين قبلوا فقط بإدارة إقليمية في إطار السودان الموحد، وهكذا تأزم الوضع في الجنوب واستعرت الحرب الأهلية وشكلت حكومة منفى جنوبية.
وأمام هذه الأزمة تدخل الجيش واستولى على الحكم بقيادة العقيد جعفر النميري في 25 أيار/مايو 1969، وقد ضمت أول حكومة في هذا العهد شخصيات يسارية وقومية وشيوعية، وأقصت بل قمعت حزب الأمة والحزب الاتحادي الديموقراطي ولكن الخلاف عاد من جديد بين دعاة العروبة و الإسلام من جهة ودعاة العلمانية والاشتراكية من جهة، وبعد فشل محاولة الانقلاب الشيوعية في تموز1970، عاد النميري الرجل القوي، الذي أصبح أول رئيس جمهورية بعد استفتاء عام، وأثناء كتابة دستور جديد عاد الخلاف بين الاتجاه الذي يريد أن يذكر أن الدولة دين الإسلام والاتجاه العلماني الذي يعتبر أن الدولة كائن معنوي لا دين لها، ورغم أن بدايات النميري كانت مرتبطة باليسار، لكنه، ولتثبيت حكمه، أظهر براعة في التلون في تحالفاته ففتح المجال للإسلاميين من الإخوان المسلمين وجماعات الطرق الصوفية من الأنصار والختمية، لتصفية الحسابات مع اليسار، بل إنه وصل حد فرض قوانين الحدود أو الشريعة الإسلامية، كل ذلك بالترافق مع التدهور الخطير في الإنتاج الزراعي والصناعي. ولقيت اتفاقية الحكم الذاتي في الجنوب رفضاً من قبل المتطرفين في الجانبين العربي الشمالي والجنوبي الأفريقي، خاصة بعد تطبيق الشريعة الإسلامية التي لم يفلح نميري في إقناع الجنوبيين أنها لا تعنيهم، ومن جديد عاد التمرد العسكري الواسع في الجنوب بعد إنشاء الجيش الشعبي لتحرير السودان. ومن جديد يتدخل الجيش بانقلاب الفريق عبد الرحمن سوار الذهب 6 نيسان/ ابريل 1986م، على النميري، بعد احتجاجات وإضرابات بسبب غلاء الأسعار، ويتم تشكيل مجلس عسكري انتقالي لتولي أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية لمدة عام، وقد أوفى سوار الذهب بوعده في نقل السلطة إلى المدنيين بعد انقضاء مهلة العام، في سابقة قل نظيرها في أفريقيا والعالم العربي، فجرى تنظيم الانتخابات في موعدها وفاز فيها حزب الأمة الجديد بزعامة الصادق المهدي، ثم جاء في المرتبة الثانية الحزب الاتحادي الديموقراطي الذي كان يتزعمه أحمد الميرغني، وتولى رئاسة مجلس رأس الدولة، فيما خرج منها حزب الجبهة الإسلامية القومية وزعيمه حسن الترابي ليتصدر صفوف المعارضة في البرلمان. وكانت هذه الفترة الديموقراطية الثالثة واستمرت أربعة سنوات.
نتيجة الهزائم المتلاحقة التي منيت بها القوات الحكومية في جنوب السودان اضطرت حكومة المهدي إلى قبول اتفاقية السلام، التي أبرمها الحزب الاتحادي الديمقراطي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، لكن الحرب ضد الحركة الشعبية، التي تعتبر حركة يسارية، قد أدت إلى تصاعد قوة الحركات الإسلامية فقامت الجبهة الإسلامية في عام 1989م بانقلاب عسكري تحت اسم “ثورة الإنقاذ الوطني”. وفي بداية الانقلاب لم يكن معروفاً توجه الانقلابين السياسي ثم ظهرت الجبهة الإسلامية بزعامة حسن عبد الله الترابي وتحولت بعده الأراضي السودانية إلى قاعدة وملجأ للحركات الجهادية الإسلامية من الدول الأخرى، خاصة العربية، واستقبلت أسامة بن لادن وسهلت بعض العمليات الإرهابية في نيروبي ودار السلام عام 1998.
نتيجة لسياسات الحكومة السودانية فقد تردت علاقاتها الخارجية وتمت مقاطعة السودان وإيقاف المعونات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إدراجه عام 1993 ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى اضطر السودان إلى طرد بن لادن عام 1996. وعلى خلفية الأزمة المشتعلة في دارفور أصدر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ل. أوكامبو في لاهاي مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير متهماً إياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
بتاريخ 9 يناير / كانون الثاني 2011، أٌجري استفتاء أدلى فيه سكان جنوب السودان بأصواتهم، واقترعوا بنسبة كبيرة لصالح الانفصال وبذلك يقفل باب مشكلة الجنوب بالحل التاريخي، رغم انه يعني خسارة قرابة ثلث مساحة البلاد.
طوال المرحلة الممتدة من انقلاب عبود 1958 ولما يزيد عن 55 عاماً، كان الدستور السوداني ينوس بين مصدرين للتشريع الدستوري “الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع” أو “حكم الشريعة الإسلامية” رغم وجود بعض المحاولات البرلمانية والسياسية للتوجه نحو العلمانية او حتى التوجهات “الاشتراكية” في بداية عصر النميري، بخلاف ما جرى في مصر وليبيا وسوريا واليمن وقبلها العراق فقد كانت السلطة الدكتاتورية في هذه البلدان تمثل أنظمة عسكرية بلبوس اشتراكي- قومي كأنظمة البعث والناصرية وملحقاتها في اليمن وليبيا، وكانت بمجملها معادية للإسلام السياسي، أما في السودان فقد حكم الإسلام السياسي بشقيه الصوفي “الأنصار والختمية” طويلاً، وعانى الشعب من فساد ونهب وديكتاتورية حكامه وحروبهم الأهلية بسبب عدم تعاملهم بشكل ديموقراطي مع قضايا الأقليات الإثنية، فكانت النتيجة انفصال الجنوب في تعبير طبيعي عن حق تقرير المصير، وقبول ذلك كأمر واقع.
ومن جديد توفرت الظروف الداخلية، التي يمكن التعبير عنها بتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء أسعار المعيشة وتفشي الفساد الحكومي واستمرار الحرب في الأقاليم، وانتهت الاحتجاجات إلى توافق عسكري مدني في 11 أبريل 2019، فأعلن الجيش خلع الرئيس عمر البشير عن السلطة وبدء مرحلة انتقالية لمدة عامين تنتهي بإقامة انتخابات لنقل السلطة. وهنا يمكن اعتبار الظروف الداخلية التي مر بها السودان، المصدر الرئيسي لهذه التغييرات الجذرية سواء على مستوى التغيرات الجغرافية أو التغييرات الدستورية نحو حيادية الدولة تجاه الأديان.
وبالطبع فإن التغيرات الداخلية في أي بلد تتأثر بالأوضاع الإقليمية والعالمية، وبهذا المعنى جاءت التدخلات الداعمة للتوجهات الجديدة، بعد ثورة 2019، سواء من مصر والسعودية والإمارات أم من الولايات المتحدة، التي قدمت الكثير للسودان الجديد. وقد يكون المقابل الذي طلبته أمريكا هو التطبيع مع إسرائيل لشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب. ويبدو أن الظروف الصعبة التي تعيشها السودان الآن قد دفعت المجلس الانتقالي لقبول هذه العملية، التي لم تواجه حتى الآن إلا معارضة محدودة من شخصيات هامة مثل الصادق المهدي وبعض الإسلاميين وبعض الأحزاب القومية والشيوعية. في حين يشير استطلاع للرأي إلى رفض أغلب السودانيين للتطبيع.
على الأقل بالنسبة لنا كسوريين، تشكل المبادئ الدستورية التي أقرها المجلس الانتقالي حلاً للقضايا الدستورية الأساسية التي واجهت السودان، وكما جاءت في الإعلان:
فصل الدين عن الدولة، والحيادية في القضايا الدينية، وكفالة حرية المعتقدات وألا تتبنّى الدولة أي ديانة لتكون رسمية في البلاد، ويتضمن الإعلان “منح الحكم الذاتي للأقاليم السودانية وإنشاء جيش قومي موحد يعكس التنوع السوداني”.
يبدو أن المعاناة الطويلة للسودانيين مع الدساتير الإسلامية وحكم الإسلاميين، وإعاقة حل قضايا الإثنيات في جميع مناطق السودان، وليس فقط في جنوبه، قد أدت إلى هذا الإعلان، الذي قد يتصور المراقب صعوبة قبوله في بلد يشكل فيه المسلمون الغالبية الساحقة من السكان دون مشاكل واحتجاجات ، لكنه حتى الآن يحظى بتأييد فعاليات سياسية واقتصادية وبقبول عام، رغم وجود بعض المعارضات، وهذا يعني أن مراحل الحكم السابقة المديدة، قد أدت إلى رغبة عامة لدى السودانيين بالانتقال إلى دستور علماني عصري يعطي جميع السودانيين حقوق المواطنة.
تيار مواطنة
مكتب الإعلام 6 نيسان/ ابريل 2021
![]()