التجربة التونسية.. دروس واستنتاجات- أحمد علي محمد

عندما أحرق البوعزيزي نفسه مدشنا بذلك ودون أن يدري انطلاق قطار ثورات الربيع العربي، فإنه لم يقم بهذا الفعل من أجل الحصول على حق التصويت في الانتخابات، بل قام به احتجاجا على حرمانه من حقه في العمل وكسب الرزق، ولا يختلف حال البوعزيزي عن حال معظم الشباب العربي المنتفض في مختلف الساحات، المحروم من حقه في العمل والحياة الحرة الكريمة، انطلاقا من ذلك يتبين لنا أن الثورات العربية لم تنطلق إلا حين تراكبت المسألة الديموقراطية مع المسألة الاجتماعية بشكل خاص، ومع المسألة الوطنية بشكل جزئي بعد أن قامت الأنظمة المستبدة ببيع أوطانها للخارج وجعلت ملايين الشباب العربي يشعر بالخزي والعار من سلوك هذه الأنظمة حيال المسألة الوطنية أيضا. ليس الاستبداد السياسي جديدا على بلداننا ، بل بدأ قبل عقود من الانفجار العربي الكبير، مع ذلك كانت الشعوب العربية متكيفة معه بأشكال مختلفة، إذ كانت الأنظمة المستبدة تراعي حساسية العلاقة بين المسألتين الديموقراطية والاجتماعية نسبيا، من خلال تأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش لهذه الشعوب مقابل حرمانها من حقوقها السياسية، لذلك بقيت قضية الديموقراطية والحريات السياسية محصورة في النخب السياسية والثقافية، التي لم تحسن للأسف الشديد ضبط إيقاع حركتها مع حركة الشارع، لأنها لم تدرك بالضبط هذه العلاقة بين المسألتين الديموقراطية والاجتماعية، وبالتالي لم تدرك حقيقة أن ما يحرك الشارع إنما هو نضج المسألة الاجتماعية وإحساس القاعدة الشعبية بأنها لم تعد تستطيع العيش بنفس الشروط السابقة.
ليس الاستبداد السياسي مفهوما مجردا وثابتا، بل هو مفهوم ملموس ومحدد بالشروط التاريخية التي يتموضع بها، من هنا لايمكن المطابقة بين الاستبداد السياسي الذي تحدث عنه الكواكبي قبل أكثر من قرن وأنظمة الاستبداد السياسي التي ثارت الشعوب العربية ضدها في نهاية العشرية الأولى من القرن الجاري، رغم وجود عناصر تشابه كثيرة بين الأثنين، لذلك إذا أردنا تعريف الاستبداد السياسي الأخير قلنا إنه الشكل السياسي الذي تتحقق به مصالح البورجوازية الكومبرادورية العربية وحلفائها في المراكز المتروبولية الغربية، والأصح أن نقول، هو الشكل السياسي الأمثل الذي تتحقق به مصالح المراكز الأمبريالية في الغرب وشركائها المحليين من بورجوازيات عربية تابعة تتمثل وظيفتها في نهب الفائض المحلي وتحويله إلى المراكز الأمبريالية، اي هو شكل الممارسة السياسية للطبقة المسيطرة أو التحالف الطبقي المسيطر، بهذا المعنى يصبح الاستبداد السياسي ضرورة لاغنى عنها للحلف المذكور من أجل تأبيد مصالحه ودوام سيطرته، ولعل هذا التعريف أن يفسر لنا كيف تنادت كل القوى الأقليمية والدولية المعادية لتطلعات شعوب المنطقة لإنشاء ذاك التحالف الدولي غير المقدس، عقب قيام ثورات الربيع العربي من أجل إجهاض هذه الثورات ومنعها من تحقيق أي من أهدافها، عبر تحويل هذه الثورات إلى ثورات مضادة، أو دفعها دفعا إلى مزالق العنف والطائفية والاقتتال العبثي، وقد لعبت قوى الإسلام السياسي بكل أطيافه ( على المستوى الداخلي وبالتنسيق مع الخارج) دورا محوريا في عملية الإجهاض هذه، لقد شكلت هذه القوى في الواقع خشبة الخلاص للأنظمة المستبدة في مختلف الساحات.
إن التعريف السابق للاستبداد من حيث الطابع الطبقي له باعتباره أداة سياسية لخدمة تحالف طبقي عولمي ( محلي –اقليمي-دولي) إنما يقودنا إلى تحديد طبيعة الثورة ضد هذا الاستبداد باعتبارها ثورة وطنية ديموقراطية اجتماعية مركبة من جهة، وتحديد القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة فيها، أي حاملها الاجتماعي، الذي هو في تقديري الطبقات الشعبية المتمثلة بجموع الكادحين المنتجين بأيديهم وأدمغتهم من جهة ثانية، وإن عدم التحديد الدقيق لطبيعة الثورة من حيث المهام والحامل الاجتماعي قد فتح الباب على مصراعيه لدخول قوى الثورة المضادة وسهل ركوبها موجة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011 ، على سبيل المثال فقد دخل الإخوان في مصر على خط الاحتجاجات بعد اسبوعين من بدء هذه الاحتجاجات. يعمل الاستبداد –وتلك وظيفته الأساسية- على منع الفئات الشعبية من تنظيم نفسها وتشكيل تعبيراتها السياسية، لذلك تجد هذه التعبيرات السياسية نفسها ضعيفة ومنهكة لحظة قيام الثورة، وتحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل إعادة بناء الذات استجابة للظروف الجديدة ( طالبت قوى الثورة السودانية بزيادة فترة الحكومة الانتقالية قبل تنظيم انتخابات، من أجل إعطائها الفرصة لتنظيم صفوفها قبل الاستحقاق الانتخابي وهي محقة في ذلك)، وفي حين تحتاج قوى الثورة إلى الوقت من أجل إعادة تنظيم صفوفها، فإن قوى الثورة المضادة تقوم بهذه العملية في زمن قياسي، بما يتوفر لها من تحالفات اقليمية ودعم خارجي على كافة الصعد السياسية والإعلامية والمالية ، وبما تمارسه من تضليل للفئات الشعبية عبر توظيف الدين في دعايتها، لذلك فإنه من الطبيعي أن تتصدر نتائج الانتخابات النيابية الأولى بعد سقوط الديكتاتور، وهذا بالضبط ماحدث في كل من مصر وتونس، ومن الجدير ذكره هنا هو أن قوى الثورة المضادة لاتقتصر على قوى الإسلام السياسي فقط، بل هي تتضمن وبشكل أساسي عناصر الطبقة المسيطرة التي تسارع إلى القفز من مركب النظام القديم حال شعورها بأن هذا المركب آيل إلى الغرق ( مثّل هؤلاء في مصر أحمد شفيق فيما مثلهم في تونس حزب نداء تونس ومجموعات ليبرالية أخرى)، تسعى قوى الثورة المضادة عند وصولها إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع إلى إفراغ الثورة من بعدها الاجتماعي، واعتبارها مجرد ثورة من أجل حق الانتخاب والتصويت وهي بذلك تفرغها من مضمونها الديموقراطي أيضا عبر اختزاله إلى مجرد صندوق اقتراع، وذلك من خلال منع وصول ممثلي الفئات الشعبية إلى قبة البرلمان من جهة، ويتم ذلك عبر صياغة قانون انتخابي مفصل على مقاسها ، كما أنها قد تلجأ إلى الاغتيالات لرموز الحركة الشعبية، كما حدث في تونس على سبيل المثال، ومن جهة ثانية عدم السماح باتخاذ أية إجراءات أو قرارات تمس مصالح الطبقة المسيطرة، وبالتالي إدارة الظهر للمطالب الاجتماعية التي حركت الشارع وأحدثت التغيير، وهي بهذا السلوك تكون قد دقت اسفينا بين المسألتين الديموقراطية والاجتماعية، وبالتالي حرمت الديموقراطية الوليدة من عناصر الحماية اللازمة والضرورية المتمثلة بالحركة الشعبية، بجعلها هذه الحركة تكفر بفكرة الديموقراطية التي لم تنعكس بشكل إيجابي في حياتها مطلقا، وهذا ما عبر عنه الشعب التونسي عند إحجامه عن تلبية النداء الذي وجهه الغنوشي للاعتصام أمام البرلمان من أجل حماية الديموقراطية، إثر الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، لا بل إن جزءا مهما من الحراك الشعبي قد أيد الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد، ذلك أن الفئات الشعبية المفقرة والمهمشة لاتملك وعيا كافيا بأهمية الديموقراطية في حياة البلاد ما لم تقترن بتحسن ملحوظ في حياتها ومعيشتها، ولقد أعطت هذه الفئات فرصة كافية للطبقة السياسية التي أفرزتها الثورة لكي تقوم بالإجراءات اللازمة لإصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتأمين فرص العمل للشباب، لكن هذه الطبقة السياسية أضاعت الفرصة عبر هدر الوقت في المماحكات السياسية والتجاذبات بين أطرافها ، صحيح أن التجربة الديموقراطية في مصر لم تأخذ وقتها كما هو الحال عليه في تونس، مع ذلك يمكن القول بأن نسبة هامة من الشارع المصري قد هللت في البداية لانقلاب السيسي، وذلك لأن الإخوان في مصر كانوا قد سارعوا إلى تطبيق برنامجهم المتمثل بالسعي إلى أخونة الدولة والمجتمع، الأمر الذي ترفضه أغلبية المصريين، ولم يحسنوا التكتيك الذي قامت به حركة النهضة في تونس.
رغم أوجه التشابه العديدة بين التجربتين المصرية والتونسية، إلا أنه ثمة فوارق تجعل من الصعوبة بمكان القول بأن مايجري حاليا في تونس إنما هو مطابق لانقلاب السيسي في مصر، يأتي في طليعة هذه الفروقات الدور المحوري الذي لعبه الجيش المصري في الحياة السياسية المصرية منذ أحمد عرابي مرورا بعبد الناصر وحسني مبارك ثم المجلس العسكري الانتقالي بعد قيام ثورة يناير وانتهاء بانقلاب السيسي، الأمر الذي لانجده في تاريخ تونس الحديث؛ إذ لم يكن للجيش التونسي هذا الدور، ولم يعبر قادته عن طموحهم إلى السلطة، هذا أولا، ثانيا وعلى العكس من ذلك يبرز في تونس الحضور المميز للمجتمع المدني ممثلا بالاتحاد العام للشغل، الذي أثبت غير مرة دوره الفاعل وقدرته على التأثير في مجريات الحدث التونسي، يضاف إلى ذلك التقاليد الدستورية العريقة ومنظومة القوانين والمؤسسات التي أرسى دعائمها مؤسس تونس الحديثة الحبيب بورقيبة، بناء على ما تقدم أجد من الصعوبة بمكان التكهن بما ستؤول إليه الأمور، فقد تحمل لنا التجربة التونسية المزيد من المفاجآت، يبقى الأمر مرهونا في تقديري بموازين القوى على الأرض، وبحجم التدخلات الخارجية واتجاهات تأثيرها، وبقدرة قوى الحراك الشعبي على تجميع قواها وتوحيد صفوفها وفرض نفسها كقطب ديموقراطي اجتماعي وازن وفاعل في حاضر ومستقبل البلاد السياسي، لكن الشيء الثابت أن الطريق طويل ومليء بالمطبات وربما بالألغام ، خاصة في ظل العولمة وإفرازاتها التي أقل ما يقال فيها أنها ليست في صالح الديموقراطية.
ليست الديموقراطية حلا سحريا لكل المشكلات الإقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها بلداننا كما قد يتوهم بعضهم، لكنها المدخل الذي لابد منه للتعامل الصحيح مع هذه المشكلات ووضعها على سكة الحل، وهي النظام الوحيد الكفيل بوضع قضايا الناس بين أيديهم وحثهم على حمايتها والدفاع عنها، لذلك على الحركة الشعبية التونسية التمسك بهذا النظام والدفاع عنه ضد محاولات التعدي التي قد تقوم بها الطبقة المسيطرة، والعمل على تخليصه من الشوائب ودفعه نحو مزيد من الدمقرطة لكي يكون أكثر ملاءمة لمصالح الناس الديموقراطية والاجتماعية، وأكثر قدرة على الاستجابة لطموحاتهم في العيش الحر الكريم.
* أحمد علي محمد/ كاتب سوري – ١٨ آب ٢٠٢١
** الآراء الواردة في المقال تعبر عن وجهة نظر صاحبها وليس بالضرورة أن تعبر عن وجهة نظر الموقع.
![]()

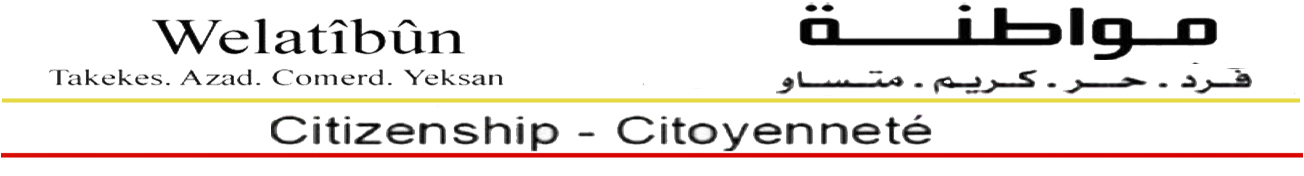
AHMAD MOHAMAD
الرجاء تصحيح اسم الكاتب وهو (أحمد علي محمد) وليس (محمد علي محمد) مع الشكر سلفا
محرر
تم مع الشكر للتدقيق