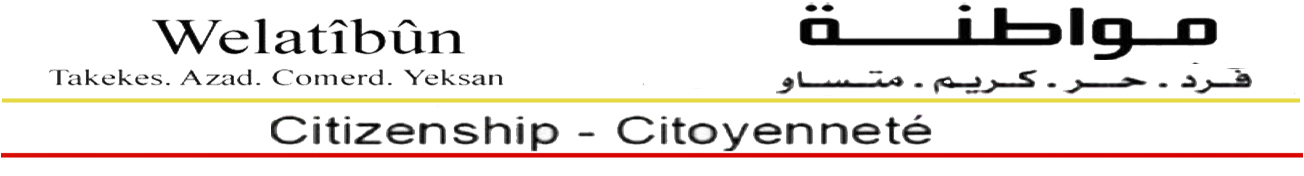المعري..تحطيم التمثال أم رأس (فكر) صاحبه؟
المعري..تحطيم التمثال أم رأس (فكر) صاحبه؟
منذ بداية تحركهم، كان بديهيا أن يضع المحتجون السوريون نصب أعينهم تحطيم صور ونُصب عائلة الأسد، التي كانت – ولا زالت في بعض المناطق – تملأ الشوارع والساحات، بما ترمز إليه من طغيان وجبروت امتدّا لعقود طويلة، تذكرّك أنىّ توجهت وحللت، أنهم لك بالمرصاد، يراقبونك، يحصون عليك أنفاسك، كلماتك، ضحكاتك، و..و..وإحساسك بالحياة. وهي تحيل بمعنى ما إلى ضرب من ضروب «الوثنية» الجديدة، من خلال تأليه الحاكم وإضفاء صفات القدسية والخلود عليه، في وقت باتت فيه وثنية عصرنا تتجسد في عبادة المال والمنصب، أومن يستحوذ عليهما، أكثر من أي شيء آخر.
أما تحطيم تمثال الحكيم والشاعر أبي العلاء المعري، في مدينته معرّة النعمان، على يد فئة متشددّة، أو نفر من المسلحين، فإنه يشوش الصورة ويخلطها في أذهان الكثيرين. فما الرابط بين نُصب عائلة الأسد، التي أقيمت كرها وقسرا، أو نفاقا، تمجيدا لطغيانها ودوام سيطرتها وتخليدها، و التي بنيّت من عرق وأموال ودماء السوريين، وبين تمثال المعري، ذلك الشاعر الزاهد المتقشف، العازف عن متاع الدنيا واغواءاتها، والذي لا يد له أصلا في صنعه، بل أقيم تكريما له بعد قرون طويلة من رحيله؟!.
نعم المعري كان شاعرا بليغا، ومتفلسفا شكاكا منفتح العقل والفكر حد الشقاء، شغلته اللغة بمكنوناتها، وهجس بأسرار الحياة والديانات والوجود والكون والأساطير، متمردا على ما راج وأشيع من أفكار وخرافات في عصره،(العصر العباسي الذي عاش فيه حفل وازدهر بالمعارف والعلوم والآداب والأسماء اللامعة في مختلف تلك الحقول، ولولا ذلك لما برز اسم المعري ووصل إلى ما وصل إليه!). قد تتفق معه وقد تختلف، لكن عليك أن تقرّ له أنه لم يفكر يوما في جمع ثروة أو في الوصول إلى منصب، (أو حتى في ذبح دجاجة)، ناهيك عن فكرة التوريث، فهو رفض حتى إنجاب الأبناء (هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد). فأي وجه للمقارنة بينه وبين آل الأسد؟ وكيف يخطر ببال أحد أن «يتهمه» بأنه كان من أجدادهم؟!.
رفض الصورة والتجسيد
قد يكون الدافع وراء هدم تمثال المعري لا صلة له بأفكاره ورؤاه، بل مجرد تعبير عن موقف «الإسلام» الرافض للتصوير والتجسيم، إذ تزامن فعل ذلك مع حدثين وقعا في مصر وهما؛ سرقة رأس تمثال عميد الأدب العربي طه حسين من مدينته التي وُلد فيها، ووضع النقاب على الوجه السافر لتمثال أم كلثوم في مسقط رأسها أيضاً.
و قبل ذلك بسنوات، سبق وتجرأ قوم باسم الإسلام على هدم تحفة عالمية، من طراز تمثال بوذا في باميان، الذي احتضنه الأفغان، ومعه أتباعه من البوذيين، أحقاباً طويلة، قبل أن يهيمن عليهم الفكر الطالباني وفتاواه المهلكة. ولا يقتصر موقف بعض الإسلاميين على تحطيم التماثيل فقط، إنما يمتد ليشمل تهديم الأضرحة ونبشها، وتهديم المقامات الدينية، وعلى ذلك، انتشرت دعوات إلى هدم الأهرام وتماثيل الفراعنة، وهو ما لم يكن ليخطر ببال «فاتح مصر» عمرو بن العاص أبدا. وينسحب موقفهم هذا طبعا على المسرح والسينما والموسيقى والغناء وما إلى ذلك.
وإذا كان الأمر على هذا النحو، فلا بد من الاعتراف أن الفكر الإسلامي المعاصر والمتشدد منه بوجه خاص يواجه مأزقا حقيقيا على هذا الصعيد، وخصوصا في وقتنا الراهن. فعصرنا هذا بات يعرف بعصر «الصورة»، وثقافتنا بثقافة الصورة، فهي أضحت تلاحقنا في كل وقت ومكان عبر وسائل الاتصال المختلفة والمتنوعة، من تلفزة وأجهزة اتصال وشبكات تواصل الكترونية وصحافة وإعلان..الخ. ولو قيض للمعري أن يكون بيننا الآن لهاله الأمر بكل تأكيد، ليس لأنه فاقد البصر فحسب، بل لأسباب كثيرة، ليس أقلها أنّ الصورة، مهما عظم شأنها، ليس بوسعها أن تصنع ثقافة حقيقية للفرد أو الجماعة.
وعليه، فليس بوسع الإسلاميين أن يستمروا في محاربة الصورة، (ومختلف أنواع الفنون كفروع لها)، في وقت تبدّلت فيه أحوال العصر وظروفه، لا لشيء سوى أن يبقوا مخلصين، أو بالأحرى أسرى، لأحاديث وأقاويل متناقلة يضفون عليها صفة القداسة والثبات الأزلي.
والواقع، فإن الموقف العدائي من الصورة والتجسيد ليس بدعة إسلامية خالصة، بل تمتد جذوره إلى الديانات التوحيدية، بدءا من اليهودية، ومرورا بالمسيحية التي شهدت في بعض عهودها، موجة من تحطيم الأيقونات ورسوم القديسين في بعض الكنائس الأوروبية، بتأثير من المرجعية اليهودية وتحريماتها المتشددة حول هذا الموضوع.
والموقف الذي ما انفك ينظر إلى الصور والتماثيل بوصفها تشغل المؤمن عن ذكر الله، أو تمهّد للإشراك به، يجافي منطق التطور التاريخي، ويخرج عن إطار الواقعية والعقلانية، وإدراك أهمية الدور الذي باتت تلعبه الصورة وطغيانها في هذا العصر.
تحطيم الرأس المفكر
أما إذا كان تحطيم التمثال يتصل بفكر المعري وتخيلاته الشعرية، وهو الاحتمال الأرجح في ظننا، فإننا سنكون أمام نكوص تاريخي يرتد بنا إلى عصر محاكم التفتيش والفتاوى القاتلة. وأقله، سيادة الرأي الواحد واللون الواحد والحزب الواحد…الخ. وهو ما ثار الشعب السوري ضده أصلا.
ففي عهدي الأسد، الأب والابن، كانت هناك درجات ومراتب لتصنيف المواطنين، حسب مدى قربهم من السلطة الحاكمة وولائهم لها. وكيما تنجح الثورة وتستحق اسمها، عليها أن تزيل هذا التمييز أولا، وتقيم مساواة كاملة بين المواطنين بصرف النظر عن جنسهم وفكرهم واثنيتهم وديانتهم وطائفتهم، بما في ذلك أولئك الذين قد ينظر إليهم على أنهم ملاحدة، أولا دين لهم.
وفضلا عن ذلك، فمن المعروف أنه ليس ثمة محتوى أو قراءة واحدة، لدى «الإسلام السياسي» للعديد من الأشياء، بما فيها الموقف من الصورة والفنون، فـ «إسلام» العدالة والتنمية في تركيا، هو غير «إسلام» عمر البشير في السودان، وغير «إسلام» الملا عمر وصحبه لدى «طالبان» أفغانستان. وهو ما نلاحظه الآن أيضا في دول «الربيع العربي»، حيث نجد خلافا واضحا تجاه هذه القضايا، بين العديد من القوى الإسلامية المعتدلة، بما فيها «الإخوان المسلمين»، وبين غيرها من القوى السلفية والمتشددة.
هنا يصح القول أن «اختلاف أمتي رحمة»، وبغير ذلك، يصبح مشروعا أن تنهض الخشية من الانتقال من استبداد إلى آخر، من استبداد سياسي دموي إلى استبداد ديني دموي أيضا.
في أيامنا هذه التي «تنعجن» فيها دماء الضحايا بتراب الأرض، يصحّ أيضا أكثر من أي وقت آخر قول صاحب «رسالة الغفران»: «خفف الوطء ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد». فهل نخفف الوطء على أديم الأرض وعلى نفوس وعقول البشر أجمعين؟
دمشق 5/3/2013 تيار مواطنة
![]()