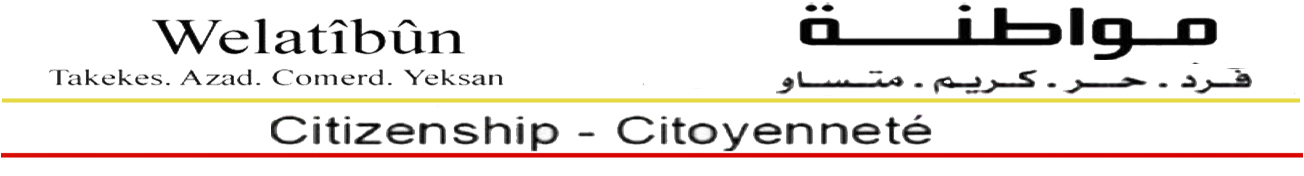قضايا ساخنة 13/12/2013
قضايا ساخنة
أولًا- الوضع الميداني:
يجب ألا يماري أحد في أن الشهور السبعة الأخيرة حملت في طياتها بعض الانتصارات المتفرقة للسلطة السورية وبخاصة في أعقاب معركة القصير الأكثر أهمية من بينها حتى الآن، ولكن ليس من المستبعد انعكاس المسار في المستقبل –وحتى القريب منه- في العديد من المناطق إذا استطاع المقاتلون استخلاص العبر من كل ما جرى خلال العامين الفائتين، والمؤشرات على ذلك في التنظيم والاتحاد والميدان لا تخفى على العين البصيرة، بل وعلى تلك الحسيرة. وإذا كان من الصحيح أن الهزائم يمكن أن تؤدي إلى الإحباط والانقسام والتشتت وتبادل الاتهامات بالمسؤولية عما حدث، فإنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تعميق النظر في الأسباب التي أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه والعمل الجاد على تجاوزها والبناء عليها إسوةً بالقول المأثور “إن الهزيمة تفتح طريق النصر”، وذلك في حال المراجعة المسؤولة وأخذ العبر الضرورية. وبهذا المعنى فإن أهم أسباب التراجع والاستنقاع واستعصاء الوضع يكمن في الافتقار إلى وحدة المقاتلين التنظيمية وغياب الاستراتيجية الواحدة على نطاق البلاد بالكامل، بما في ذلك الافتقار إلى سلم الأولويات القتالية، حيث لم يعد خافيًا إلا على الجهلاء أن الكثير من المعارك والجبهات لم تكن في محلها، وأن الكثير من المواقع سقطت لا لنقص في العدد والعتاد المطلقين، بل لغياب التنسيق والدعم ووحدة القتال والمقاتلين، والأمل معقود على أن تدفع الحاجة ودروس الهزيمة إلى تدارك الأسباب السابقة وغيرها للوصول بالوضع إلى ما يجب، بل ما يمكن أن يكون عليه تنظيميًا واستراتيجيًا وقتاليًا.
لقد عجزت الدعوات العقلانية –كما يبدو- حتى وقت قريب عن الدفع بالاتجاه المطلوب، فعسى أن يكون مبدأ “الحاجة أم الاختراع” وراء إمكانية الوحدة على الصعد كافة في المستقبل المنظور.
ومن المشكوك فيه أن يستطيع أحد الإتيان بمثال عن ثورة فيها مئات، بل ربما آلاف الفصائل المقاتلة، كما هو الحال عندنا، وإذا كان تفسير هذه الظاهرة السلبية انطلاقًا من طبيعة الثورة ومنشئها المحلي الدفاعي في الأصل ومن التدخلات الخارجية وتنوع وتعدد أطراف الدعم… الخ، نقول: إن كان ذلك كذلك فإن استمرار الوضع على ما هو عليه لا ينبئ بخير على الإطلاق، إن لم نقل أكثر.
ومن حق الغيورين على مستقبل الثورة والبلاد أن يستغربوا أشد الاستغراب كيف يمكن لعشرات بل ربما مئات الفصائل أن تجتمع فقط لسحب الاعتراف بالائتلاف الوطني أو التهديد به إذا أقدم على الذهاب إلى جنيف، ولا تجتمع هذه الفصائل نفسها في سياق مؤسسة عسكرية مركزية موحدة على الصعد كافة، وبخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار العنصر البشري المقاتل وأيديولوجيا القتال والهدف منه والطريق الموصل إليه… الخ. لقد أتيح للثورة السورية ما لم يتح لغيرها على صعيد العناصر المذكورة، ولذلك فإن استمرار الفرقة والتشرذم يثير الاستنكار وليس الاستغراب فقط، والمراهنة اليوم على الانتقال من الصراخ حول أسباب بعض الهزائم من مثل الافتقار إلى الدعم والسلاح والذخيرة… الخ إلى البناء على ذلك كله. ومن الإنصاف القول: إن تباشير هذا البناء قد بدأت في الظهور في الأيام القليلة الأخيرة، والأمل معقود على السير قدمًا في الاتجاه الجديد؛ اتجاه وحدة البندقية السورية المقاتلة التي طالما دعا الغيورون إليها دون استجابة حقيقية تذكر. وهذا الاتجاه هو أهم بكثير، بل ويأتي في المقام الأول قبل كل كلام مكرور عن ضرورة الدعم بالسلاح النوعي والمال والخبرة… الخ.
إن وحدة البندقية هو الشرط الذي لا مفر منه وإن يكن غير كافٍ لإحداث أي اختراق نوعي من قبل الثورة في الوضع الميداني الراهن، إن يكن ضد السلطة-الطغمة أو في مواجهة “داعش” ومن لف لفها ومن يصب الحب في طاحونتها، أو حتى في مواجهة الطرفين معًا عند الضرورة التي لا مهرب منها، أو لفرض وضع ميداني -تلوح تباشيره في الأفق وفي غير مكان- ووضع مؤسسي يمكن البناء عليهما ليس عسكريًا فحسب، بل وسياسيًا في حال الدخول في عملية تفاوض قد تفرض علينا بحكم الوقائع العنيدة.
إن توحيد البندقية السورية المقاتلة سيساهم بشكل إيجابي بالتأثير عليها ويمكن المراهنة على تغيرات فعلية في الاستراتيجية السياسية التي تتبعها لأن من شأن هذه الوحدة –أي البندقية- أن يجعلها أقرب إلى القبول –ولو جزئيًا- بالمعادلات السياسية الدولية والإقليمية بل وحتى المحلية، بما في ذلك فتح الإمكانية المستقبلية للسير باتجاه تشكيل جيش وطني سوري حر حقيقةً، وإن يكن في المستقبل غير المنظور، وهو الشعار الذي ينبغي ألا نمل من التأكيد عليه.
ثانيًا- الوضع السياسي – مؤتمر جنيف 2
أ- خلفيات المؤتمر: بوسع المرء أن يختار إجابات قصيرة واضحة أو مراوغة في الجواب على الأسئلة المطروحة حول إمكانية انعقاد المؤتمر المذكور، ومرجعيته وإمكان نجاحه أو فشله… الخ، والموقف السليم من ذلك كله.
وعلى النقيض مما سبق، نحن نفضل أن ننظر في السياق التاريخي الراهن الذي يدفع إلى جنيف أو عنها، ويمكن القول باختصار: إن جنيف هو ضرورة دولية متفق عليها على نحو مبدئي على الأقل، بغض النظر عن كونه ضرورة داخليًة وتنبع الضرورة المذكورة من الإرادة الدولية في مواجهة التطرف على الأرض السورية، بل وقطع الطريق عليه. وبهذا المعنى فإن الرجل الأولى لجنيف قائمة، وتبقى الرجل الأخرى التي هي مواجهة السلطة-الطغمة السورية محل خلاف حتى الآن، ويبدو أن المستقبل القريب لا يحمل في طياته الاتفاق الضروري. لذلك فإن جنيف هو أعرج حتى الآن، وكيما يسير على رجليه الاثنتين لا بد من اقتناع من لم يقتنع حتى الآن، وبخاصة روسيا وإيران (وثمة مؤشرات وإن تكن ضعيفة على توفر هكذا إمكانية للاقتناع)، بأن مواجهة التطرف قولًا وفعلًا تقتضي دحرجة رأس السلطة-الطغمة السورية، وعلى رأسها رئيس الأمر الواقع، ثمنًا لهذه المواجهة. على اعتبار أن من بين الأسباب الخمسة للتطرف والعنف ثمة اثنان يخصان السلطة-الطغمة، والأسباب هي: الميل العام للصحوة الإسلامية إلى التطرف والعنف وموقف المجتمع الدولي المتخاذل من الوضع السوري والقمع البهيمي للسلطة والطابع الطائفي السافر لهذا القمع والتفاف طوائف عدة حول السلطة وتبريرها المطلق لأفعالها البربرية.
وللمزيد من تسليط الضوء على الرجلين المذكورتين يمكن القول: إنه لا أحد تقريبًا في هذا العالم، بدءًا بأميركا وانتهاءً بروسيا وإيران وحزب الله مرورًا بأوروبا والعالم العربي، وبخاصة دوله الفاعلة، يريد أن يدعم أو يقبل بقيام دولة إسلامية متطرفة في سورية الأمر الذي يعني أن مواجهة التطرف له مصداقية حقيقية عند هذه الدول جميعًا بغض النظر عن ترجمة هذه المواجهة والأساليب والسيناريوهات المتبعة التي لا نصوبها بالضرورة، بل لنا عليها ما يكفي من الملاحظات النقدية. وفي كل الأحوال يبدو أن مبدأ “درهم وقاية خير من قنطار علاج” -وهو المبدأ الصحيح بحق- يحكم وجهة نظر الدول الفاعلة أو صانعة القرار حتى لا تتكرر أخطاء ماضٍ عرفناه جيدًا في أفغانستان وأماكن أخرى.
إن المشكلة إذن لا تكمن هنا، بقدر ما تكمن في الأصل في البديل السوري وكيفية بنائه ودور المعارضة السياسية والمقاتلين والسلطة-الطغمة السورية فيه. ولذلك لا غرابة إذا كانت مسألة السلطة-الطغمة ودورها في عملية التسوية السياسية هي لب الخلاف والصراع والعقدة شبه المستعصية مثلها في ذلك مثل البديل السوري المنشود، وعندما يتم الاتفاق على ذلك دوليًا وإقليميًا وعربيًا يمكن لجنيف كما قلنا أن يسير على رجلين، وحتى ذلك الوقت لكل حادث حديث.
ب- إمكانية انعقاد مؤتمر جنيف 2: قلنا إن الدفع باتجاه جنيف هو دولي أكثر منه محلي، وبهذا المعنى فإن السلطة-الطغمة والمعارضة السورية شبه مرغمتين على حضوره، إن لم نقل أكثر، ناهيك عن المقاتلين على الأرض الذين أعلنوا غير مرة رفضهم أو قبولهم المشروط بشروط لا يستطيعون توفيرها داخليًا اليوم ولا يوفرها المجتمع الدولي. ومع ذلك فإن الاتجاه العام للدول الفاعلة يضغط بكل قواه من أجل انعقاده ويدفع المعارضة السورية بقوة إليه ومن المرجح أن هذه الضغوط آتت أكلها، ما لم تكن هنالك مفاجآت في المستقبل القريب، ومع ذلك فإن التأجيلات المتكررة لموعد المؤتمر يدفع إلى الاستنتاج بصعوبة انعقاده وبضرورة تذليل بعض العقد أو القضايا الشائكة والتي من أهمها مسألة تسليم السلطة في سياق انتقالي وفي سياق رحيل أو تنحٍ متفاوض عليه بعد التخلي عن الرحيل المباشر كشرط سابق لكل تفاوض، ومع ذلك لا يحظى مبدأ الرحيل المتفاوض عليه بالتسليم الكافي، فلا السلطة-الطغمة تقبل به ولا المعارضة قادرة على القبول بأقل منه ولا على فرضه بالقوة الذاتية على طاولة المفاوضات، الأمر الذي يجعلها تعوّل التعويل كله تقريبًا على ما تسميه ضمانات دولية وعربية لا وضوح ولا حسم فيها أبدًا حتى الآن، ولا يقدم ولا يؤخر فيما عدا ذلك كل الرطانات الإنشائية التي نسمعها من كل حدب وصوب في معسكر السلطة أو معسكر الثورة على حد سواء.
وبانتظار أن تذلل بعض الصعاب وأن ترتب بعض الأوضاع فإن جنيف 2 بوسعه الانتظار على الرغم من أن الوضع سيبقى باتجاه الانعقاد، وقد يكون ذلك هو المرجح في نهاية المطاف.
ج- مسألة المرجعية: نسمع الكثير من الأقوال المتذاكية عن رفض الشروط المسبقة لانعقاد جنيف، وهو في الحق كلام باطل ويراد به الباطل، لأن البداهة تقول: ليس هنالك مؤتمر في العالم يعقد بدون مرجعية. ولذلك فإن الحديث عن مرجعية لجنيف هو كلام حق وبديهي، فإذا كانت هذه المرجعية موجودة فيبنى عليها، وإلا فإن إيجادها أمر ضروري لا يدخل أبدًا في سياق الشروط والشروط المضادة.
يمكن القول في سياق ما سبق إن المرجعية موجودة بصورة أولية في “جنيف 1″؛ في المبادئ الستة التي صار عمرها قبل جنيف 1 وبعده سنتين من مبادرة الجامعة العربية، وفي المبدأ الأساسي الذي ينص عليه في جنيف 1 والذي هو قيام جسم سياسي انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، ونؤكد هنا على تنفيذية بقدر ما نؤكد على كاملة، الأمر الذي يعني بالفعل سلطة حقيقية حاكمة بشرعية ناجزة وبقوة كافية وبوضع غير متنازع عليه للقيام بواجبها الأول والأخير الذي هو الوصول إلى سلطة بديلة للسلطة-الطغمة الراهنة ولسلطتها هي بالذات. وفيما عدا ذلك فإن الشروط التي نسمع بها ليل نهار هي أقرب ما تكون إلى أهداف ومطالب وتمنيات يسعى إليها كل طرف لتثقيل وزنه وإرضاء جمهوره وتصليب موقفه ورفع سقفه، وما تحقيق هذه المطالب أو عدم تحققها إلا رهن بالمستقبل وبالمتغيرات المنظورة وغير المنظورة اليوم بالضرورة.
وما دام الأمر كذلك، فإن التفاوض سيطول في حال حصوله وسيغرق على الأرجح في تفاصيل لا أول لها ولا آخر، لأسباب معروفة للجميع ليس أقلها شأنًا الهوة العميقة والعميقة جدًا الفاصلة بين الطرفين وعجزهما المتبادل عن فرض الشروط الخاصة بكل منهما.
د- إمكانية النجاح والإخفاق: انطلاقًا مما سبق يمكن القول: إن جنيف 2 سوف يخفق على الأرجح حتى في حال انعقاده، ما لم تكن هنالك مفاجآت غير منظورة اليوم، من بينها أن يوافق الروس على دحرجة السلطة السورية ورأسها ثمنًا لمواجهة التطرف، أو التدخل الفعلي بالقوة لإجبار الطرفين على الحلول الانتقالية الوسط، أو حصول مفاجآت على الأرض تسمح بفرض هذا الشرط أو ذاك، أو تؤدي إلى فرط المؤتمر أو غير ذلك، أو تسليم الفصائل المقاتلة باستحالة قيام الدولة الإسلامية كما تطرح حتى لو كان بالإمكان تحقيق الانتصار العسكري من قبلها –أي الفصائل، وهو الأمر الذي لا يلوح في الأفق أصلًا. وهو الأمر الذي يتطلب تعزيز الحوار المتواصل مع هذه الفصائل لإقناعها بهذه الاستحالة تمهيدًا لتصويب الموقف من الحل السياسي وشروطه المطلوبة. وعلى المقلب الآخر، لا بد من اقتناع السلطة الطغمة أيضًا ليس باستحالة الانتصار العسكري فحسب، بل باستحالة استعادة سلطتها كما كانت حتى لو كان بالإمكان تحقيق الانتصار المذكور.
وفي كل الأحوال، إذا تصورت السلطة-الطغمة أنها ذاهبة إلى جنيف لفرض شروطها أو لرفض الرحيل المتفاوض عليه فإنها تخطئ السبيل والعنوان، والأمر نفسه فيما يخص الطرف الآخر الذي يخطئ السبيل والعنوان إذا اعتقد أنه قادر على فرض الحد الأقصى من أهداف الثورة على طاولة المفاوضات بعد أن عجز عن تحقيقها على الأرض، وبخاصة في ظل غياب إجماع دولي مصمم على ذلك وقادر عليه. وحتى ذلك الوقت فإن موقف الثورة والأهداف المشروعة لها هي محط دعم من قطاع واسع من الدول الفاعلة، وقد تجلى ذلك في بيان لندن وفي مرجعية جنيف، ولكنها بحاجة ماسة إلى ظهير عسكري موحد على الأرض يشكل أساسًا وسندًا حقيقيًا لها في سياق التفاوض، وهو ما يجب العمل عليه في سياق وحدة البندقية السورية المقاتلة وفي سياق الوصول إلى اتفاق سياسي عريض مع الأرض لتشكيل هذا الظهير الضروري، وذلك كي لا يجازف الائتلاف الوطني بخسارة الأرض أو بخسارة جنيف أو كليهما معًا. ولتعزيز الموقف السابق لا بد من أن يكون وفد المعارضة موحدًا وبقيادة الائتلاف وباستراتيجية موحدة وبلغة واحدة تطال كل القضايا الرئيسية والفرعية وبسيناريو تفاوضي هجومي يجعل الكرة دائمًا في مرمى العدو أو على الأقل في الجزء الذي يخصه من الملعب، وهذا يعني رفضًا لألعاب الروس وللشخصيات المطروحة من قبلهم، كما يعني تشكيل وفد كفء بحق لهكذا مفاوضات؛ عارف بأدق التفاصيل وحازم في المسائل الكبرى. وينبغي توفير قاعدة دعم لوجستي صلبة له كما هو الحال تمامًا في وجود مستشارين على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية… الخ.
وعند هذا الحد، إذا نجح جنيف فأهلًا به، وإذا أخفق فأهلًا به أيضًا، لأننا نكون قد حولناه إلى ساحة للصراع السياسي المفتوح لنيل الدعم الدولي والإقليمي والعربي الحقيقي، وللدفاع عن الثورة وأهدافها المشروعة ولحصار السلطة-الطغمة في الزاوية، وإلى توفير الشروط الضرورية على الأرض وفي السياسة للوصول بالثورة إلى مآلها الطبيعي. وفي كل الأحوال إن مجرد إقلاع جنيف ستكون له آثار نفسية حقيقية حتى بدون النجاح على كل الأطراف المتصارعة وعلى كل الطوائف في سورية الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية مباشرة وغير مباشرة على البديل الثالث لسورية في المضمون والزمان والمآل.
ونحن نرجح أن جنيف مصمم من أجل ثلاث مسائل: مواجهة التطرف، وإيجاد حل للسلطة –وبخاصةٍ رأسها- ومن أجل استيلاد البديل الثالث منهما معًا (أي قوى الثورة والنظام) في سياق الإبقاء على جزء من جهاز الدولة بالمعنى الشامل للعبارة ودمجه بقوى الثورة الراهنة باستثناء الفصائل المتطرفة، وهذا إذا نجح فإنه يصب في مصلحة الوطن والشعب والمستقبل.
ثالثًا – الحكومة المؤقتة
سبق أن أشرنا غير مرة إلى المقدمات الفعلية اللازمة لوجود حكومة مؤقتة فعلًا وقولًا، وكان من أهمها: (1) توفير الدعم الدولي القانوني عبر النزع الكامل للشرعية عن السلطة-الطغمة وإضفائها على الحكومة المؤقتة في كل المحافل الدولية بدءًا بالجامعة العربية وانتهاءً بالأمم المتحدة، (2) توفير الدعم السياسي الحازم من مجموعة دولية وإقليمية وعربية قادرة وراغبة في ذلك، (3) توفير الدعم المالي الكافي وتوحيده ومركزته، (4) وجود أرض محررة أو شبه محررة لقيام الحكومة عليها ومد أذرعها وشرايين إمدادها إلى هناك أو من هناك إلى كل مكان يمكن الوصول إليه في سورية، (5) التنسيق التام –إن لم نقل أكثر- مع القوى الفاعلة على الأرض وبخاصة المعارضة المسلحة والمجالس المحلية. (6) ضرورة وجود ذراع ذاتية مسلحة قادرة على حماية الحكومة أو توفير ذلك عبر اتفاق واضح مع المعارضة المسلحة أو مع بعض فصائلها على الأقل. (7) توفر الكادر على الصعد كافة سياسيًا وتكنوقراطيًا وبخاصة على صعيد الإدارة والخدمات والاقتصاد.
وبوسع هذه المقدمات الضرورية، بالإضافة إلى أخرى أقل أهمية، أن توقف الحكومة على رجليها، فأين نحن منها الآن؟ نحن نعتقد أن بعضها محقق مثل الدعم المالي وتوفر الكادر وقدر من الدعم السياسي، لكن بعضها الآخر لا يزال غائبًا أو محدودًا مثل الشرعية القانونية والأرض المحررة والذراع العسكري وهي ضرورات أساسية. ومع ذلك نحن نعتقد أن هذه الحكومة يجب دعمها والعمل بإخلاص لدفعها إلى الأمام بعيدًا عن المخاوف الباطلة التي توجه لها من مثل الخوف من المساهمة في تقسيم البلاد أو زيادة انقسام المعارضة، أو تعقيد الحلول السياسية، إذ على النقيض من ذلك كله، فإنها يمكن أن تكون محطة إيجابية لوحدة الدعم ومركزته ووحدة الجهة القائمة بذلك، ما يساهم في وحدة المقاتلين إيجابيًا ووحدة الأرض كذلك. كما يمكن أن تسقط ذرائع غياب هيئة تنفيذية لها حضور وهو السبب الذي يقدم لغياب الاعتراف، وسوف تكون في أسوأ الأحوال مقدمة واقعية لمنازعة السلطة-الطغمة على الشرعية القانونية والاجتماعية، كما سوف تكون ممرًا إلى ترميم الإدارة وتوصيل وتفعيل الخدمات الضرورية للشعب حيث يوجد في الداخل والخارج، وسيكون من شأن ذلك وجود جسم قادر على الاستقطاب الشعبي واستعادة دور السياسة والمجتمع المدني، بل ويمكن الذهاب أكثر نحو إمكانية أن تكون الممر الأساسي لأشكال الدعم كافة للمقاتلين على الأرض وللتأثير على الولاءات القائمة والاصطفافات الراهنة بما يسمح بقيام اصطفافات أخرى أقرب لأهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة، ولا شيء يمنع أبدًا من أن تكون هذه الحكومة أو بعضها جزء لا يتجزأ من الهيئة الانتقالية في حال قيامها طبقًا لجنيف 1، أو تكون بديلًا عنها في حال عدم قيام المذكورة لاحقًا. وفي كل الأحوال فإنه من المتوقع –وإن يكن جزئيًا- أن تساهم الحكومة المؤقتة في حال إقلاعها في المضي قدمًا بالوحدة العسكرية والسياسية المركزية للمقاتلين، بما في ذلك وضعهم تحت التأثير الإيجابي الفعلي للمعادلات السياسية الراهنة وللائتلاف ذاته.
وإذا كان من الصحيح أن المنظور السابق غير متشائم فيما يخص الحكومة المؤقتة، فإنه لا يغفل أبدًا نقاط ضعفها الحقيقية التي قد يكون مقتلها فيها، وهو أمر ليس بالمستبعد، وكل ما في الأمر أنه يركز على الإمكانات الإيجابية مهما تكن محدودة مع العمل على استخراجها وتعزيزها والدفع بها للمساعدة في تذليل الصعاب الفعلية التي تواجهها.
بقي أن نقول إن هكذا حكومة كان من شأنها أن تقوم بمهامها في مواجهة طرف أساسي هو السلطة-الطغمة، ولكنها اليوم سوف تضطر إلى القيام بها في مواجهة أطراف ثلاثة على الأقل، هي السلطة-الطغمة وحلفاؤها، وداعش وأمثالها، وحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي (PYD) وحلفاؤه، بل والوضع الكردي بشكل عام. ولذلك لا غرابة في أن تكون الإدارة الكردية الذاتية قد نشأت جنبًا إلى جنب أو في سياق قيام الحكومة المؤقتة، والأمر نفسه قيما يتعلق بالنشاط المحموم لداعش ومثيلاتها لفرض وقائع على الأرض، ليس في مواجهة السلطة-الطغمة فحسب، بل في مواجهة مشروع الحكومة المؤقتة ذاتها. وبهذا المعنى فإن الحكومة المذكورة سوف يكون لها دور ملموس –إذا استطاعت الوجود الفعلي- وإيجابي في مواجهة المخاطر التي يشكلها حزب (PYD) وداعش وأمثالها والسلطة-الطغمة ذاتها.
رابعًا – الوضع الإقليمي
ما يحدث في لبنان من تفجيرات وارتفاع حدة التوترات السياسية والأمنية، والتطورات الجارية في مثلث الحدود السورية ـ التركية ـ العراقية، وسقوط عدة قذائف على الأراضي السعودية قرب مثلث الحدود السعودية ـ الكويتية ـ العراقية، تؤشر إلى أن منعكسات ومخاطر الصراع في سورية على محيطها الإقليمي قد خطت خطوات جديدة نحو التصعيد والتسخين، بعد أن كانت في طور الكمون والإمكانات، أو ما يشبه الحرب الباردة. فمنذ انطلاق المظاهرات الشعبية السلمية المطالبة بالحرية والكرامة، عمد النظام إلى إطلاق حملة محمومة من التهديد والوعيد لتخويف دول الإقليم، بل ودول العالم أجمع، من انتقامه ونقل العنف والإرهاب إلى داخل حدودها وحرق أراضيها. وبعد تحول الاحتجاجات إلى انتفاضة ثم إلى ثورة، ثم اضطرارها إلى حمل السلاح دفاعًا عن المتظاهرين والمدنيين العزل، كان من الطبيعي أن تتعإلى التحذيرات والتنبوءات، وتتعدد الآراء الأبحاث والدراسات، حول مخاطر انتقال الصراع والعنف من الداخل السوري إلى الجوار الإقليمي. وقد سبق تحقق تلك التوقعات والاستنتاجات، إن لم نقل النبوءات، التدخل الكبير والفعّال لدعم النظام، على الرغم من فداحة جرائمه بحق الشعب السوري، من قبل روسيا وإيران وأدواتها الإقليمية. وعلى وجه الخصوص بعد انتقال تدخل حزب الله والميليشيات العراقية من مرحلة التستر والتدخل محدود الفعالية، إلى مرحلة التدخل العلني والمتفاخر والفعال لدرجة التأثير في موازين قوى الصراع منذ “القصير” و”ما بعد بعد القصير”.
ومع حرصنا الشديد على عدم الانجرار إلى التهويلات، وحتى التهويمات، ونظريات المؤامرة حول سايكس ـ بيكو جديد، وإعادة رسم خرائط المنطقة، والتقسيم، والشرق الأوسط الجديد، إلى ما هنالك من تسميات، لا يمكننا في المقابل تقزيم خطورة تلك الأحداث وتداعياتها المتدحرجة مثل كرة الثلج التي تبدأ صغيرة.
ففي لبنان لم يستطع حزب الله حصر مواجهته داخل الحدود السورية. ولم تنجح دعوته المتذاكية لمن يريد أن يقاتله أن يلاقيه على الأراضي السورية. ولكنه أدخل لبنان في مرحلة “العرقنة”، كما يقال، وقرّبه أكثر فأكثر من حافة الحرب الأهلية. وها هو الرئيس اللبناني ميشال سليمان يحذر من “استقلال أطراف لبنانية عن منطق الدولة”، و”تخطي الحدود والانخراط في نزاع مسلح”، وقال في الذكرى السبعين لاستقلال لبنان “لا يمكن أن تقوم دولة الاستقلال، إذا ما قررت أطراف أو جماعات لبنانيّة بعينها، الاستقلال عن منطق الدولة، أو إذا ما ارتضت الخروج عن التوافق الوطني، باتخاذ قرارات تسمح بتخطّي الحدود والانخراط في نزاع مسلّح على أرض دولة شقيقة، وتعريض الوحدة الوطنيّة والسلم الأهلي للخطر”.
لا تشكل القذائف التي أطلقتها ميليشيا شيعية عراقية على الأراضي السعودية، قرب مثلث الحدود العراقية ـ السعودية ـ الكويتية، أية أهمية عسكرية أو أمنية. لكنها ذات دلالة رمزية ليست قليلة الأهمية تقول أن إمكانية تسخين الحدود، والإقليم، إمكانية قائمة وقابلة للاشتعال. وهذا ما ينطبق بدرجة أكبر، وأكثر خطورة، مع اقتراب ميليشيات حزب الله من الحدود السورية الأردنية. وهو ما يفسر قول الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني إن بلاده «تنظر بقلق شديد تجاه التقارير المتواترة التي تتحدث عن وجود مجموعات متطرفة مسلحة (لم يسمها) قرب حدودها مع سورية». وأضاف أن مؤسسات الدولة الأردنية وأجهزتها «تبذل الإجراءات الضرورية كافة للحفاظ على أمن الأردن واستقراره وأمن حدوده”.
إذن المخاطر لم تعد مقتصرة على الداخل السوري وإنما تشمل دول المنطقة جميعها، كما أن الغرب مدرك لعدم إمكانية حصرها، أي المخاطر، داخل الحدود السورية. فهل يملك العالم ترف الوقوف متفرجًا؟! وهل يمكن إيقاف نيران اشتعال الإقليم على حدوده إن اشتعل؟!
خامسًا – سوف نفرد بحثًا خاصًا مستقلًا للاتفاق حول النووي الإيراني في أقرب فرصة، وعلى التداعيات التي يمكن أن يتركها على الوضع في المنطقة والملف السوري بشكل خاص.
سادسًا – الوضع الكردي
تعاني الساحة الكردية السورية، علاوةً على تعقيدات القضية القومية الكردية والتشابكات الإقليمية، من تعقيدات الوضع السوري العام، ما خلا بعض التفاصيل الناجمة عن تشابكه بهذا المستوى أو ذاك مع العمق القومي الكردي في دول الجوار: تركيا والعراق على وجه الخصوص، بسبب الارتباط الجغرافي المباشر والارتباطات العائلية والعشائرية والاجتماعية على جانبي الحدود، بالإضافة عوامل أخرى عمقت من رهان الكرد السوريين على الكرد في تركيا والعراق لإنقاذهم من الاضطهاد، منذ تأسيس منظمة “خيبون” في عشرينات القرن الماضي ومن ثم تأسيس ” الحزب الديمقراطي الكردستاني” في سورية في العام 1957، ولغاية الآن. وهذا التشابك بين الوضع الكردي في سورية والوضع الكردي في كل من تركيا والعراق يأخذ منحى أكثر عمقا في مراحل الأزمات، ويكون ذلك مفهومًا لراهنية المسألة القومية الكردية في كل أجزاء كردستان. ونتيجة لذلك، ولخصوصية المسألة الكردية في سورية تحظى القوى السياسية الكردية في العراق وتركيا بتأثير عميق ليس فقط على القوى السياسية الكردية في سورية وإنما على قطاعات واسعة من المجتمع الكردي السوري.
وفي سياق الثورة السورية بدأ تأثير حزب العمال الكردستاني – تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني – العراق يأخذ شكلًا أكثر وضوحًا على مجريات الأوضاع في المناطق الكردية السورية وعلى توجهات الحركة السياسية الكردية؛ فكان لسياسة “النأي بالنفس” التي مارستها حكومة إقليم كردستان العراق في بداية الثورة السورية -بقدر ملامستها لرغبة ذاتية عند أحزاب الحركة السياسية الكردية- تأثيرها الواضح على توجهات المجلس الوطني الكردي، الذي تشكل على قاعدتها، ومارس حزب العمال الكردستاني نفوذه على الساحة الكردية السورية من خلال حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الذي يعد فرعًا تابعًا له، يخضع لأجندته ورؤاه ويلتزم بالأطر العامة لتحالفاته وسياساته، كما كان للخلافات التي برزت بمرور الوقت بين المحورين الكرديين السوريين: “المجلس الوطني الكردي” و”مجلس شعب غربي كردستان” التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وقدرة هذا الحزب على تجيير الأمور لصالحه بدعم وإسناد من نظام بشار الأسد الأثر العميق على دور الكرد السوريين في الثورة السورية، دون أن ننسى طبعًا ما لهذا الحزب –ومن ورائه حزب PKK- من حضور قوي في الذاكرة الجمعية للكرد السوريين كونه حاملًا للمشروع القومي الكردي في تركيا وقاتل طويلًا من أجل ذلك وجند الكثير من الأكراد السوريين في حربه هناك والذين يشكلون الآن حاضنة شعبية وقاعدة صلبه له، فضلًا عن امتلاكه السلاح الآن والخبرة القتالية الكبيرة والتي تؤهله ليكون الملاذ الذي يلوذ به الأكراد لحمايتهم من تجاوزات خصومهم، هذا بالإضافة طبعًا إلى أن سياسة “النأي بالنفس المذكورة” والتي تحظى بحضور قوي لدى شريحة واسعة من الكرد السوريين لأسباب غنية عن التعريف –باستثناء جزء من الحراك الشبابي وبعض القوى السياسية الكردية- نقول أن هذه السياسة تتماشى مع الموقف الأصيل لهذا الحزب وتصب الحب في طاحونته لأنه ليس فقط ملتزماً في الأساس بسياسة النأي بالنفس (وهذا ما جعل صالح مسلم يكون جزءًا من هيئة التنسيق الوطنية)، بل إنه يذهب أبعد من ذلك إلى حد التواطؤ والتنسيق مع السلطة الطغمة.
وبدون التوغل عميقًا في التفاصيل واستطراداتها نستطيع أن نجمل المتغيرات على الساحة السياسية والثورية الكردية منذ انطلاق الثورة السورية بثلاث مراحل:
1- مرحلة بروز الحراك الشبابي والمدني: كان الشباب في المناطق الكردية مبادرين إلى التظاهر والاحتجاج في بدايات انطلاق الثورة السورية وكانوا من أوائل الحراكات الشبابية السورية في خلق أطر تنظيمية شبابية لتفعيل النضال الثوري السلمي، وقد تعاظم دور الشباب في الشارع الكردي على الرغم من كل الظروف التي كانت تدفع باتجاه الحد من دور الشباب، سواء من خلال قمع أجهزة السلطة-الطغمة الأمنية أو من خلال العراقيل والصعوبات التي كانت تضعها كثير من الأحزاب الكردية الكلاسيكية، إلا أن الشباب استطاعوا أن يستقطبوا قطاعًا واسعًا من الشارع الكردي، وقد كان للحضور الشبابي الفاعل في المشهد الثوري في المناطق الكردية الدور الأبرز في استقطابهم إلى المجلس الوطني الكردي، الذي تأسس في 26/10/2011، وكان لهم الفضل في تجاوز نسبة المستقلين وممثلي التنسيقيات والحراكات الشبابية نصف أعضاء المجلس الوطني الكردي. كما كان للشباب الثوري المستقل دورًا كبيرًا في جر قواعد الأحزاب الكردية إلى الشارع وجعلها قوة ضغط على قياداتها للانخراط علانية بالثورة.
2- مرحلة تشكل الهيئة الكردية العليا: تشكلت الهيئة الكردية العليا في 1/7/2012، برعاية رئيس إقليم كردستان العراق، من اجتماع المجلس الوطني الكردي ومجلس شعب غربي كردستان، وكان المجلس الأخير قد أسسه حزب الاتحاد الديمقراطي في 16/12/2011، برعاية رئيس إقليم كردستان أيضًا. وتمكنت الهيئة الكردية العليا إلى حد كبير من أن تحد من الفعاليات الشبابية وأن تعود بالموقف السياسي الكردي إلى البدايات الأولى، وساعدها في ذلك الانزياحات الكبيرة التي حصلت في المسارات العامة للثورة السورية عسكريًا وسياسيًا، والتغطية الكردستانية الكبيرة لممارساتها –أي الهيئة الكردية العليا- وتسويقها كرديًا بكل الأشكال والأساليب، على الرغم من أن الخلافات برزت في الهيئة الكردية العليا في أسابيع تأسيسها الأولى، إلا أن حزب الاتحاد الديمقراطي استطاع استثمار الهيئة سيفًا مسلطًا على معارضيه ومناوئيه السياسيين، وخاصة الأطر والفعاليات الشبابية. واستطاع الاتحاد الديمقراطي أن يجرد كل الأحزاب الكردية من السلاح ويخلق جوًا من الرعب بين كوادر الأحزاب وقياداتها وبين الناشطين الشباب. ومنذ مجزرة عامودا في 27/6/2013 التي قامت بها قوات حزب (PYD)، عجزت الهيئة الكردية العليا عن الاجتماع لمرة واحدة بشكل اعتيادي وبنصابها القانوني الكامل، وأصبح حزب الاتحاد الديمقراطي سلطة الأمر الواقع في عموم المناطق الكردية ولم يسمح منذ مجزرة عامودا بأي فعاليات ثورية (مظاهرات، اعتصامات، احتجاجات… الخ). ونتيجة الاغتيالات والاعتقالات والمضايقات المستمرة والتحكم بسبل العيش أجبر العديد من الناشطين الشباب وكوادر الأحزاب الكردية الأخرى إلى الهجرة.
3- مرحلة استفراد حزب (PYD) باسم الهيئة الكردية العليا: في هذه المرحلة بدأت العديد من الأحزاب الكردية المنضوية تحت لواء المجلس الوطني الكردي بانتقاد الهيئة الكردية العليا وإعلان تجميد عضويتها والتوجه نحو التلاقي مع الائتلاف واستطاع المجلس الوطني الكردي بعد جهود حثيثة أن يحسم قراره باتجاه الانضمام إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة. وقد دفعت ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي الأحزاب الفاعلة في المجلس الوطني الكردي إلى إعلان قطيعتها مع حزب الاتحاد الديمقراطي وتجذير موقفها تجاه الثورة ومعاداة النظام.
إن قدرة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) على السيطرة على المناطق ذات الغالبية الكردية في سورية –علاوةً على ما ذكرناه أعلاه- تعود في أحد أسبابها إلى الخطاب المرتبك لقوى المعارضة السورية تجاه المسألة القومية والديمقراطية في البلاد وصعود الخطاب الإسلامي المتشدد الإقصائي، والضعيف الحضور أصلًا على الساحة الكردية، الأمران اللذان ساهما بشكل فعال في تنشيط الذاكرة الشعبية الكردية المفعمة بالإحباط والانتكاسات من قوى المعارضة، ليس في سورية وحسب، وإنما في مجمل الوضع الكردستاني، وكان أخرها انتفاضة 2004 في سورية التي تركت بدون سند تواجه آلة القتل السلطوية، وقد استغل حزب الاتحاد ذلك لمصلحته، هذا بالإضافة طبعًا إلى تهميش المنطقة معيشيًا وإغاثيًا الأمر الذي مهد له أن يكون هو “الضامن” لسبل معيشة الناس.
إن عدم دعم قوى الحراك المدني والشبابي من قبل المجلس الوطني ومن بعده الائتلاف سياسيا أو معنويا سهل على حزب (PYD) إجهاض الحراك وإخراجه من المعادلة السياسية. كما أن ارتباك موقف إقليم كردستان العراق تجاه الثورة كان أيضًا من الأسباب التي سهلت على حزب (PYD) قضم ما تبقى من شعبية وحضور المجلس الوطني الكردي.
وفي البحث عن الحلول، لعل البداية السليمة تكمن في دعم المجلس الوطني الكردي سياسيًا ومعنويًا والاهتمام نسبيًا بموضوع الحراك المدني والشبابي وقضايا الإغاثة، ما قد يخفف من هيمنة الاتحاد الديمقراطي ويساهم في بناء دفاعات جديدة في مواجهة تمدده.
لكن يبقى الأهم من كل ذلك صياغة الخطاب الوطني الديمقراطي للائتلاف ووضع محددات واضحة له، كي لا تخرج عنه كما تصريحات متسرعة وسلبية، كما حدث في بيانه الأخير فيما يتعلق بإعلان (PYD) عن مشروعه للإدارة الذاتية.
انطلاقًا من موقفنا المبدئي من القضية الكردية وسبل حلها في سورية الذي عبرنا عنه غير مرة، وعلى الرغم من اعتراضنا على الطريقة والأسلوب والآليات التي اتبعها حزب (PYD) في الإعلان عن الإدارة الذاتية مؤخرًا بمشاركة بعض المكونات العربية والسريانية، واعتراضنا على استفراد الحزب المذكور في الإعلان عنها وعلى عدم التنسيق مع المجلس الوطني الكردي وقوى الثورة في ذلك، لا بل الإعلان عنها بالتنسيق مع السلطة-الطغمة، ورؤيتنا بأن الإعلان عنها جاء في مواجهة الإعلان عن الحكومة المؤقتة من جانب الائتلاف، وفي لحظة من شأنها إلحاق ضرر كبير بالثورة، فإننا نقول انطلاقًا من كل ما سبق أننا لا نجد مبررًا للتهويل الذي لجأت إليه قوى المعارضة السورية وبخاصة الائتلاف في الذهاب إلى اعتبار هذا الحزب خائنًا أو انفصاليًا دون غيره، وبخاصة إذا ما علمنا أن هناك مكونات سياسية عربية وأخرى سريانية شاركته في هذا الإعلان!!! لكننا من جانب آخر نأخذ عليه استفراده بهذه الخطوة كما قلنا وابتعاده عن التوافق الوطني، وهو أمر في غاية الأهمية فالقضية الكردية في سورية لا يمكن أن تحل إلا بشكل سلمي وتوافقي، ناهيك عن أن هذا الموقف قد عبر عنه عدد من الأعضاء في المجلس الوطني الكردي، مما يدل على الحكمة والواقعية والوطنية السورية، وهو أمر جدير بأن ترفع له القبعة.
ونحن نعتقد أن الإدارة الذاتية المطروحة لا تخرج عن الإدارات المحلية المطروحة وان اتخذت طابعًا قوميًا لا يمكن إخفاؤه، ولذا فان ذلك ليس بموقع الاستهجان بالنسبة لنا وإن يكن بموقع الحذر والتحفظ في التوقيت والآلية والسيناريو الذي نشأ قيه، ونحن نعتقد أنها قد تكون مخرجًا جيدًا إذا قامت على قاعدة توافق وطني عام بعد تحقيق أهداف الثورة السورية وضمن ترتيبات سورية المستقبل لحل المسألة الكردية في سورية حلًا ديمقراطيًا.
خلاصة القول بعد كل ما سبق، إن الوضع اليوم بعد إجهاض الضربة الأمريكية عبر تقديم السلاح الكيماوي يختلف كثيرًا عما قبله، ولابد من تلمس الطريق الصحيحة على قاعدة المتغيرات الفعلية التي طفت على السطح والتي تتطلب درجة عالية من المسؤولية والموضوعية والروح النقدية والجرأة على اجتراح موقف صائب يقوم على مقدمات قد لا تتطابق بالضرورة مع المقدمات التي كانت قائمة قبل حكاية الكيماوي، بل وقد تكون مغايرة لها إلى هذا الحد أو ذاك.
المكتب التنفيذي لتيار مواطنة
13/12/2013
![]()